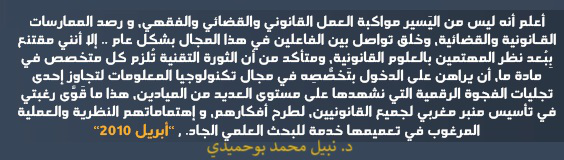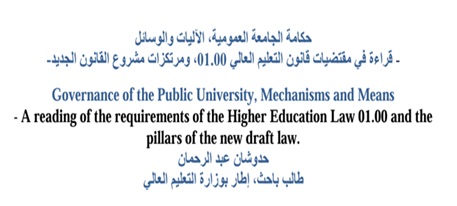
ملخص:
Abstract:
ظهر مفهوم الحكامة خلال تسعينات القرن الماضي، وفرض نفسه في الساحة الجامعية، حيث برز بشكل واضح مع الإعلان عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين في 8 أكتوبر1999، وتجسد هذا المبدأ خلال مجموعة من الإصلاحات والمخططات والاستراتيجيات التي عرفها قطاع التعليم العالي، بدءا من قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي(25 ماي 2000)، إلى جانب مجموعة القوانين التنظيمية المرتبطة به، مرورا بالمخطط الاستعجالي الذي يمتد لأربع سنوات (2009_2012)، وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015_2030 (من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء) المعلن عنها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين في فاتح ماي 2015، والتي تتضمن في مقتضياتها ضرورة تنويع نماذج مؤسسات التعليم وتحديث قطاع التعليم العالي وأنظمته، وذلك من خلال وضع هيكلة تناسب المهام، ومراجعة تركيبة وطريقة اشتغال مجالس الجامعات ومجالس المؤسسات ودعم استقلالية بنيات التدبير وتأهيلها للقيام بأدوارها، وتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع التعليم العالي والجامعي بالأخص (الرافعة الخامسة عشرة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح).
Abstract:
The concept of governance emerged during the 1990s and imposed itself in the university arena, where it clearly emerged with the announcement of the National Charter for Education and Training on 8 October 1999. This principle was embodied during a series of reforms, plans and strategies in the higher education sector, starting with Law 01. 00 on the organization of higher education (25 May 2000), along with a series of related regulatory laws, through the four-year emergency plan (2009-2012), to the Strategic Vision for Reform 2015-2030 (for a school of equity, quality and progress) announced by the Higher Council for Education and Training on 1 May 2015, which includes in its requirements the need to diversify the models of educational institutions and modernize the higher education sector, and the modernization of the higher education sector and its systems, through the development of a structure appropriate to the tasks, reviewing the composition and modus operandi of university and institutional councils, supporting the independence of management structures and qualifying them to carry out their roles, and updating the legal and institutional framework of the higher education sector and university in particular (the fifteenth pillar of the Strategic Vision for Reform).
مقدمة
من أهم هذه الإصلاحات ما جاء به ظهير 25 فبراير 1975 الذي يعد بمثابة أول تنظيم شامل للتعليم العالي[3]، والذي يعتبر دفعة قوية لسد الفراغ القانوني والمؤسساتي، من خلال إحداث رئاسة الجامعة ومهامها واختصاصات رئيس الجامعة وتنظيم المؤسسات الجامعية بما في ذلك إحداثها وتأليفها وتسييرها، لكن على مستوى المضامين لا نلمس فيه إلا منح استقلالية شكلية للجامعات، وذلك بالنظر أساسا إلى تركيبة مجالس الجامعات ومجالس الكليات، وإلى الاختصاصات المخولة لها، في مقابل الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها السلطة المركزية[4]، وأيضا حالة الاختناق والانسداد التي علقت بالجامعة المغربية ومحدودية هذا الإصلاح، خاصة ما جاء به تقرير البنك الدولي سنة 1995، جعل الملك المرحوم الحسن الثاني يبعث برسالته إلى البرلمان بتاريخ 8 مارس 1999 يطلب فيه بتحديد التوجهات العامة التي يجب أن يشملها الإصلاح التعليمي، ودعا إلى تشكيل لجنة لهذا الغرض سميت بلجنة الميثاق الوطني للتربية والتكوين من خلالها تمت بلورة مبادئ الميثاق وصدور القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي(19 ماي 2000)[5]، وشكل هذا القانون محطة رئيسية في تاريخ الجامعة المغربية من سماته الأساسية استقلالية الجامعة والرقي بها إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والبيداغوجي، وقد تم اعتبار الفترة 2000-2009 بمثابة العشرية الوطنية للتربية والتكوين تم من خلالها تحقيق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التعليم العالي[6].
لكن رغم ذلك بقيت الانتظارات كبيرة والتحديات مستمرة ومتنامية، ما دفع الوزارة إلى إعداد برنامج استعجالي 2009-2012، من أجل تسريع استكمال الإصلاح طبقا لتوجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث تم إبرام عقود بين الدولة والجامعات، من المبادئ الأساسية لهذا التعاقد: الاستقلالية والمساءلة، والتتبع والتقييم ومهننة التكوينات، لكنه اتسم هو أيضا بمحدوديته وفشله في تحقيق الأهداف المسطرة، والحال أن السياسة العمومية مطالبة بإدماج مبدأ الاستمرارية في التوجهات من أجل إتمام الإصلاحات، ما جعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين يتخذ مجموعة من التدابير لإنقاذ فشل المخطط بإصدار "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030"[7]، وحتى يكون لهذه الرؤية الطابع الإلزامي عند تنزيلها تم استصدار القانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي[8]، والذي يعتبر اليوم سند تشريعي لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من بين مضامينه تنظيم التعليم العالي وتطوير عرض التكوين وتحديث أنظمته الأساسية وإعادة هيكلته من خلال قانون جديد للتعليم العالي محل القانون الحالي 01.00.
عزز القانون رقم 01.00 الاستقلالية البيداغوجية والإدارية والمالية للجامعات، ووسع من مهامها، وعدل من تمثيلية بعض الفئات في مجالس الجامعات ومؤسساتها، في ظل هذه الحالة التي عليها الجامعة المغربية يحق لنا أن نتساءل عن أسس ومضامين حكامة التعليم الجامعي؟ ومدى نجاعة وإلتقائية الإصلاحات التي عرفها هذا القطاع؟ وكيف ساهم الإطار القانوني للجامعات في خلق دينامية جديدة مواكبة لمتطلبات الفترة الراهنة والمستقبلية؟ وما هي أهم التحديات والمعيقات التي حالت دون تنزيل وتحديث مقتضيات قانون التعليم العالي؟ وماهي أهم التوجهات الجديدة التي تبنتها الوزارة الوصية لحكامة الإدارة الجامعية ومواردها البشرية؟ وإلى أي حد وفقت السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع والهيئات والمجالس المعنية في بلوغ الأهداف الأولية المعلنة عنها ضمن استراتيجية 2015_2030؟
وتفترض الورقة البحثية أن الجامعة المغربية تواكب قضايا المجتمع ومتطلبات الجودة في التعليم على حد سواء خصوصا في الآونة الأخيرة، إذ سيكون المنهج المتبع في التأكد من هذه الفرضية هو المنهج الوظيفي إلى جانب المنهج التحليلي الوصفي، عبر التطرق أولا إلى بنيات وآليات تدبير الجامعة وحكامتها من خلال القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي (المحور الأول)، ثم أهم التوجهات والاستراتيجيات المقررة اعتمادها من أجل تحسين وتحديث وضعية الهياكل الجامعية ومواردها البشرية (المحور الثاني).
المطلب الأول: المؤسسات الجامعية وآليات التدبير على ضوء القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي
بعد حصول المغرب على الاستقلال قام بإحداث مجموعة من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا لتلبية حاجيات البلاد من الأطر والكفاءات الإدارية التي ستتولى مهمة التسيير والتدبير[9]، وأيضا نتيجة تزايد عدد الطلبة ومن هنا جاءت ضرورة فصل إدارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المصالح المشتركة لوزارة التربية الوطنية، لكون التعليم الجامعي له خصوصيات مغايرة للتعليم الابتدائي والثانوي، وأيضا في نفس هذا القطاع، مما فرض ضرورة استقلال الجامعات عن باقي الأصناف الأخرى[10].
غير أن ما ميز هذه المرحلة هو افتقاد المغرب لسياسة واضحة ورؤية استراتيجية متكاملة، ونظرة عميقة لواقع التعليم الجامعي ونظامه الإداري فقد استمرت الإدارة المركزية في ممارسة الاختصاصات التي خولها ظهير 25 فبراير 1975 للجامعات، مما يوحي إلى أن صدور هذا الأخير جاء نتيجة لظروف مرحلية، ومن أجل إعطاء نفس جديد للجامعة المغربية كان لا بد من البحث عن إطار قانوني بديل ملائم للتطورات والتحديات الجديدة[11]، تمثل في قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الذي جاء استجابتا لمجموعة من التحولات الداخلية والخارجية وكإصلاح شامل للقطاع نال توافق جماعي، حيث تضمن هذا القانون مائة مادة مقسمة على ستة أبواب تتضمن مجموعة من المقتضيات والآليات التنظيمية تؤسس لحكامة الجامعة ومؤسساتها.
فماهي أهم المقتضيات والآليات التنظيمية التي نص عليها القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؟ وكيف ساهمت في حكامة المؤسسات الجامعية؟ وما أهم الاختلالات والمعيقات التي تحد من فعاليتها؟
الفقرة الأولى: الجامعة والآليات التدبيرية المتعلقة بها
يعد القانون رقم 01.00 المتعلق بالتنظيم العالي، قانونا إصلاحيا برزت قوته في الاعتراف بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي والبيداغوجي للجامعة وتمكين أجهزتها من مجموعة من الاختصاصات الإدارية والمالية تزاولها بشكل مستقل عن السلطة المركزية في إطار ممارسة مهمة تدبير المؤسسات الجامعية، وتوزيع المهام وتحديد اختصاصات الهياكل، إضافة إلى دعم انفتاح الجامعة ومؤسساتها على محيطهما الاقتصادي والاجتماعي، بضم أعضاء من خارج المؤسسة لمجالسها[12].
مصطلح الجامعة مشتق من الجمع، فهي فضاء لتجمع الطاقات والتخصصات المختلفة،[13] عرّفها ظهير1975 في الفصل الثاني، بأنها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وعزز القانون 01.00 من استقلاليتها الإدارية والبيداغوجية والعلمية والثقافية،[14] وأيضا من استقلالية المجالس الجامعية وتوسيع اختصاصاتهم.
أولا: مجلس الجامعة وطبيعة الاختصاصات
يعتبر مجلس الجامعة الهيئة العليا على مستوى الجامعة، أدخل عليه القانون 01.00 عدة تغييرات بالمقارنة ما كان عليه في ظهير 25 فبراير 1975، حيث كان هيئة استشارية فأصبح بمقتضى هذا القانون هيئة تقريرية.
تطرق ظهير 1975 لتركيبة المجلس في فصله السادس عشر، والمهام المنوطة به في الفصلين السابع عشر والثامن عشر، أما طريقة التسيير فقد نص عليها في الفصلين التاسع عشر والعشرين حيث كان المجلس يتألف من أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين وآخرين معينين[15]. أما القانون رقم 01.00 جعله أكثر انفتاحا وأدخل عليه مجموعة من التعديلات، أهمها إشراك عدة فعاليات محلية وجهوية قصد الدفع بفتح المسالك والشعب وملاءمتها مع المحيط الاقتصادي، غير أن تركيبة المجلس وعدم توازنه يثير مجموعة من الملاحظات حول مدى عزم المشرع في تكريس مبدأ الاستقلالية والحكامة الجامعية.
- تأليف مجلس الجامعة
- رئيس الجامعة؛
_ رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة؛
_ مدير أو مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعين من قبل مجلس التنسيق؛
- رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة المعنية؛
- سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من بينهم رؤساء الغرف المهنية وممثل واحد عن التعليم العالي الخاص[16] رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة المعنية؛
- أعضاء منتخبين: ثلاثة ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين في كل مؤسسة جامعية، ثلاثة ممثلين عن المستخدمين الإداريين والتقنيين بالجامعة، ثلاثة ممثلين منتخبين عن الطلبة بالجامعة[17].
يتراوح عدد أعضاء الجامعة ما بين 50 و60 عضوا أو أكثر، بحسب حجم الجامعات وعدد المؤسسات الجامعية، وهذا العدد الكبير من الممثلين يجعل من مجلس الجامعة هيئة متعددة الأصوات، يصعب في إطارها مناقشة القرارات والتفاوض حولها والمصادقة عليها، علينا الإقرار بوجود فروق بين الجامعات بهذا الخصوص، ومع ذلك فهي تواجه جميعها صعوبات في تسيير هيئة كثيرة العدد[19]، من الأصح من خلال المرسوم رقم 2.01.2326 المتعلق بتحديد كفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات[20]، الاستغناء عن الفقرة الأخيرة من المادة 3 التي تشير" إذا لم تتوفر مؤسسة جامعية على عدد كافي من المترشحين الممكن انتخابهم بالنسبة لإطار معين، يحول المقعد الشاغر لفائدة إطار أعلى أو إذا تعذر ذلك يحول إلى الإطار الأقل"[21]، بغية التخفيف ما أمكن من التضخم الذي تعانيه هذه المجالس الجامعية.
- اختصاصات مجلس الجامعة
ثانيا: رئيس الجامعة
يرأس الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة، ويمكن له أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة،[24] تدرس الترشيحات والمشاريع التي يتقدم بها المرشحون من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية الوصية، وتقدم اللجنة ثلاثة ترشيحات لهذه الأخيرة وتعرضها على الوزارة الوصية ثم مجلس الحكومة للتداول في الترشيحات المقدمة، في هذه الحالة اختيار المترشح قد لا يحترم الترتيب الذي أعدته اللجنة، بينما في فرنسا ينتخب رئيس الجامعة بالأغلبية المطلقة من قبل الأعضاء المنتخبين للمجلس الإداري.[25]
يقوم رئيس الجامعة بتحضير قرارات المجلس وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه ويحدد جدول أعماله، ويقوم بالتنسيق بين المؤسسات التابعة للجامعة ويمثل هذه الأخيرة أمام القضاء والدفاع باسمها، ويفوض مجموع أو بعض سلطه إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية، كما يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الجامعة، ويساعده في ذلك نائبان وكاتب عام ويعينون من لدن السلطة الحكومية الوصية باقتراح من الرئيس[26]، إلى جانب الرئيس ومجلس الجامعة، نجد هيئة أخرى خول لها هذا الأخير صلاحيات إدارية ومالية في (المادة 9) دون التفصيل في ذلك.
ثالثا: مجلس تدبير الجامعة
يعتبر من مستجدات القانون 01.00، والذي كان غائبا في ظهير1975، ينبثق عن مجلس الجامعة، تناط به المهام الإدارية والمالية على اساس تساوي الأعضاء بين المعينين والمنتخبين، ويحدد تأليف وكيفيات تعيين أعضاءه بمرسوم[27]، كما يتضمن القانون الداخلي لمجلس الجامعة اختصاصات المجلس في الميدان الإداري والمالي وكذا اجتماعاته ومداولاته بالإضافة إلى تركيبة أعضائه.
- تركيبة أعضاء مجلس التدبير
- أعضاء بحكم القانون والمعينين: رئيس الجامعة رئيسا، رئيسان لمؤسسات جامعية بالجامعة المعنية، رئيس الجهة المعنية، رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة؛
- أعضاء منتخبين وهم: أستاذ التعليم العالي، أستاذ مؤهل أو مبرز، أستاذ التعليم العالي مساعد، ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، ممثل عن الطلبة[29].
- اختصاصات مجلس التدبير وطبيعتها:
الفقرة الثانية: تنظيم المؤسسات الجامعية
تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم في شكل كليات أو مدارس أو معاهد، وتشكل هياكل للتعليم العالي والبحث بالجامعة، وتضم شعبا مطابقة للتخصصات ولمجالات الدراسة والبحث كما تضم مصالح خاصة بها،[32] وتشتمل على مؤسسات ذات ولوج مفتوح ومؤسسات ذات ولوج محدود وعلى معاهد.[33] ويجوز لها أن تحدث بعد موافقة مجلس الجامعة مراكز للتعليم والتكوين والدراسة أو البحث أو هما معا.
أولا: رؤساء المؤسسات الجامعية
يقوم العميد أو المدير، بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها، ويتم تعيينهم وفق مباراة لمدة أربع سنوات، ويمكن أن تتجدد ولاية العميد أو المدير لمرة واحدة فقط لنفس المدة ، يتم اختيارهم بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة الجامعية المعنية،[34] ويعتبر رئيس المؤسسة المسؤول المباشر بعد رئيس الجامعة في الهرم الإداري للجامعات، ولعل هذا ما جعل المشرع المغربي يضع رئيس المؤسسة الجامعية في مقدمة التنظيم قبل مجالس المؤسسات عكس رئيس الجامعة، ويقوم العميد أو مدير المؤسسة بممارسة مجموعة من المهام، من بين أهمها:
_تسيير مجموع المستخدمين المعينين للعمل بالمؤسسة،
_ يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية، ويتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليها،
_ يسهر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرام المؤسسة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل.[35]
في إطار تعزيز استقلالية الجامعة ينبغي توسيع صلاحيات رؤساء المؤسسات الجامعية في توقيع بعض الوثائق والشواهد دون تأشير رئيس الجامعة من أجل تبسيط أكثر للمساطر الإدارية، بما أن الإثنين تم تعيينهم بمرسوم من طرف رئيس الحكومة بعد دراسة مشاريعهم الخاصة من طرف اللجن المكلفة بذلك، كما ينبغي أيضا فتح إمكانية تولي منصب رئيس المؤسسة الجامعية أمام جميع المترشحين المتوفرين على كفاءات عالية في التدبير الإداري ومشاريع خاصة ملائمة لتنمية المؤسسات الجامعية، كما هو معلن عليه بالنسبة لترشيحات تولي رئاسة الجامعة.
ثانيا: مجلس المؤسسة
يحدث على صعيد كل مؤسسة جامعية " مجلس" يتألف من مجموعة الأعضاء هم أعضاء بحكم القانون وأعضاء معينين وأعضاء منتخبين:[36]
- أعضاء بحكم القانون
- أعضاء منتخبين:
_ أربعة ممثلين منتخبين عن الأساتذة المؤهلين أو المبرزين في الطب والصيدلة أو الأساتذة المبرزين في طب الأسنان،
_ أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين والمساعدين وكذا عن أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي الذين يقومون بمهام تربوية في المؤسسة،
_ ثلاثة ممثلين منتخبين عن المستخدمون الإداريون والتقنيون حسب كل فئة،
_ثلاثة ممثلين عن الطلبة حسب كل سلك.
- أربع أعضاء معينين من خارج المؤسسة:
إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال أو وقع في حالة فقدان الأهلية، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال أجل ستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد هذا بالنسبة للأساتذة الباحثين، أما المستخدمين الإداريين والتقنيين فإن التعويض يتم تلقائيا ومباشرة بالنسبة للفترة المتبقية دون تحديد أجل لذلك (المادتين 8 و12 من المرسوم).
كما أن هذه المراسيم أكتنفها نوع من القصور فيما يخص عدم التنصيص على تمثيلية رؤساء الأقسام والمصالح نظرا لدورهما الفعال في تدبير المؤسسات الجامعية وإلمامهم الجيد بأهم الصعوبات والحلول الناجعة لتدبير هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ذلك فإن الأمر يتطلب في عملية حكامة المؤسسات الجامعية تجميع ما أمكن شتات المراسيم التطبيقية المنظمة لهذه المؤسسات، حيث كان من الأفضل تجميع المراسيم المتعلقة بمجالس المؤسسات وأهم اللجن المرتبطة بالتعليم العالي في مرسوم واحد، علما أن هذه المراسيم صدرت جلها في 4 يونيو 2002.
خلاصة
من خلال الاطلاع على بعض التقارير التي تناولت الجامعات والمؤسسات التابعة لها _ تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس الأعلى للحسابات_[37] تبين أن أولى الانتقادات الموجهة لها، هي الانتقادات المتعلقة بمجالسها، وصعوبة تدبيرها بسبب العدد الكبير لأعضائها[38]، وأيضا غياب التناسق بين مشاريع رؤساء الجامعات والخطط الاستراتيجية التي تضعها الوزارة الوصية، بل يمتد ذلك لعدم تناسقهما مع مشاريع عمداء ومديري المؤسسات التابعة له[39]، إلى جانب عدم وجود هياكل أو آليات للتنسيق بين مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات، كما لا يتم إبلاغ قرارات المجلسين لبعضهما البعض، ومن جهة أخرى عدم اعتماد آليات لتقييم أداء رؤساء الجامعات وغياب مجموعة من الآليات التي تجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر برسم سنتي 2019-2020، "أن مجالس الجامعات تتكون من عدد كبير من الأعضاء والذي يمكن أن يصل في بعض الأحيان إلى 95 عضوا، وهذا يؤثر سلبا على إدارة الاجتماعات التي تستغرق وقتا طويلا وتؤدي لنقاشات غير مجدية".[40] ناهيك عن ضعف السلطة التقريرية للمجالس، نتيجة هيمنة الرؤساء عليها، ويتجلى ذلك في الطريقة التي يتم بها تدبير جلسات المجالس، حيث أن الرئيس يقدم جدول أعمال الجلسة في غياب استشارة مسبقة لأعضاء المجلس[41]، كما ينبغي إضافة تمثيلية رؤساء الأقسام والمصالح في المجالس، لما من أهمية بالغة لهؤلاء في تدبير وتنفيذ مقررات المجالس والمشاركة الفعالة فيها.
المحور الثاني: مرتكزات مشروع قانون التعليم العالي وحكامة المنظومة الجامعية العمومية
في سياق تنزيل المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030)[42]، خاصة في شقه المتعلق بتجويد الحكامة لاسيما عبر تكييف الإطار القانوني، تشتغل الوزارة على مشروع قانون، لتغيير قانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وفق مقاربة بناء مشترك مع مختلف المتدخلين والفاعلين.
يتكون هذا المشروع من تسعة أجزاء، يتعلق الجزء الأول بأحكام وتوجهات عامة، وفي الجزء الثاني التنظيم العام للتعليم العالي، أما الجزء الثالث فهو يتحدث عن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛ بينما نجد تطوير البحث العلمي والابتكار وآليات النهوض به في الجزء الرابع، أما الأجزاء الثلاثة الخامس والسادس والسابع، فترتكز على تمويل منظومة التعليم العالي وتنويع مصادره، وهيئة رؤساء الجامعات وآليات التتبع والمواكبة والتقييم للجامعة المغربية، وفي الجزأين الاخيرين تم التطرق إلى العقوبات والمخالفات وأحكام انتقالية وختامية.
تتكون مؤسسات التعليم العالي من ثلاثة أصناف من المؤسسات التالية:
_مؤسسات للتعليم العالي العمومية،
_ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي،
_ مؤسسات التعليم العالي الكفيلة غير ربحية ذات النفع العام[43].
في إطار دراستنا لمشروع قانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي[44]، سنكتفي بتناول الأجزاء المتعلقة بتنظيم وحكامة المؤسسات الجامعية العمومية والهيئات المكونة لها، دون غيرها، نظرا لأهمية هذه المؤسسات واحتوائها على أكبر نسبة من عدد الطلبة والأطر الإدارية والبيداغوجية في منظومة التعليم العالي[45].
ترتكز حكامة الجامعة والمؤسسات الجامعية العمومية من خلال هذا المشروع على مجموعة من الآليات والهياكل المختلطة بين ما هو حديث وقديم والمتمثلة في: مجلس الإدارة، رئيس الجامعة، المجلس الأكاديمي، رئيس المؤسسة الجامعية، مجلس تدبير المؤسسة، الشعب المطابقة للتخصصات ولمجالات التكوين، بنيات البحث العلمي والابتكار ثم أخيرا الهياكل المشتركة (المادة 21).
الفقرة الأولى: الجامعات العمومية
تعتبر الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، كما تتمتع في إطار التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالاستقلالية العلمية والبيداغوجية والثقافية وحرية المبادرة في مجال الإبداع والابتكار والتميز، وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى مراقبة مدى تقيد أجهزة الجامعة بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،[46] وإلى تتبع تنفيذ الالتزامات المبرمة بينهما من خلال مجموعة من الاتفاقيات والعقود وأيضا في مجال الإطار التعاقدي[47].
اعتمد مشروع القانون هيكلة جديدة للجامعة والمؤسسات التابعة لها، وذلك من خلال إحداث مجموعة من المجالس والهياكل إلى جانب مجلس الجامعة ومجلس التدبير، ولكن دون تحديد المغزى وراء تشكيلة كل مجلس على حدة، كما تم تغيير تشكيلة هذه المجالس واسم مؤسسات التعليم العالي خلافا لما جاء في القانون 01.00، هذا التوجه الجديد في حكامة مجالس الجامعة ومؤسساتها له دلالات عديدة وقوية في نفس الوقت، توحي إلى الرغبة الأكيدة للمشرع في النهوض بدور الجامعة ومجالسها عبر إدخال شخصيات وازنة جهوية ومحلية في عضوية مجالس الجامعة.
أولا: مجلس الإدارة: يتألف مجلس الإدارة من الرئيس وأعضاء معينين من طرفه وأعضاء بحكم القانون وهم:[48]
رئيس مجلس الإدارة؛ والي الجهة المعنية؛ رئيس مجلس الجهة المعنية؛ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛ أعضاء معينين من طرف رئيس مجلس الإدارة، وهم: ثلاث شخصيات يمثلون قطاعات الانتاج والخدمات؛ رئيس جامعة خاصة أو شريكة؛ شخصيتان من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وخبرتها في أحد المجالات العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.[49]
يسهر مجلس الإدارة على تتبع تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على صعيد الجامعة، كما يمارس من أجل ذلك السلط والصلاحيات اللازمة لدعم وتتبع وتقييم الجامعة المعنية، في تنفيذ أداء مشروع تطويرها وتحسين مردوديتها وحسن سيرها، عبر المصادقة على هيكلتها ونظامها الداخلي ومخططات العمل السنوية، كما يعمل على اتخاذ القرارات الهادفة إلى إحداث مؤسسات وأقطاب أو مراكز ملحقة والمختبرات ومراكز البحث وغيرها من بنيات البحث الأخرى التابعة للجامعة، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الهادفة إلى اقتناء أو تفويت الممتلكات العقارية والمصادقة على قبول الهبات والوصايا[50]..
ثانيا: رئيس مجلس الإدارة
يرأس مجلس الإدارة شخصية من الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها، يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يسهر الرئيس على إعداد جدول أعمال المجلس بتنسيق مع رئيس الجامعة، ويختص بالإضافة إلى ذلك على دراسة التقرير السنوي لحصيلة أنشطة الجامعة وبرامج العمل والمصادقة عليها، كما يقوم بحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية ودارسة وحصر مشروع ميزانية السنة الموالية وغيرها من المهام الأخرى المنوطة به (المادتين 23و24).
بينما يعمل رئيس الجامعة على تسيير شؤون الجامعة وتطويرها، ويقوم أيضا بتحضير وإعداد مشاريع قرارات مجلس إدارتها، وتنفيذها، كما يمكنه اقتراح بعض الأعمال والمشاريع أو اتفاقيات من شأنها أن تعمل على تطوير أداء الجامعة والمؤسسات التابعة لها[51].
ثالثا: رئيس الجامعة
يرأس الجامعة العمومية رئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار من بين الشخصيات المشهود بكفاءاتها وتجربتها بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة وتحسين أدائها ومردوديتها، بعد اختيار وتعيين الرئيس يقوم بعرض مشروعه قبل الشروع في العمل به، لدراسته من طرف مجلس الإدارة، وقبل إحالته على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل النظر في مدى ملائمته مع الإطار التعاقدي بين الدولة والجامعة.[52]
- اختصاصات رئيس الجامعة:
وهذه المهام المتعلقة برئيس الجامعة ينبغي إعادة النظر فيها، أو على الأقل منحه بعض المهام ذات صبغة تقريرية، لأنه في الأصل هو الشخص الذي تم اختياره لرئاسة الجامعة، من بين المترشحين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، بعد دراسة مشروعه الخاص بتطوير الجامعة وتنميتها، من طرف المجلس واللجنة المختصة بذلك، قبل تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، حيث نجد في مضمون المشروع (المادة 29)، أن الصلاحيات والسلط الممنوحة للرئيس لا تتجاوز مسألة التسيير والإعداد والتوقيع ثم الاقتراح والتنسيق والتوزيع والتنفيذ، وهذه المهام تنقص من مكانة الرئيس، وتعبر على تراجع المشرع عن الصلاحيات القديمة الممنوحة له، إما لدواعي فشل وعدم قدرة القيادات الجامعية في تعزيز استقلالية الجامعة والتدبير الأمثل لها، أو لأسباب أمنية محضة.
- تشكيلة الرئيس:
إذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق حال دون قيامه بمهامه أو الاستمرار في مزاولتها لأي سبب من الأسباب، أو في حالة شغور المنصب، ناب عنه، بصفة مؤقتة أحد نوابه شريطة أن يكون أستاذا للتعليم العالي أو رئيس من بين رؤساء المؤسسات الجامعية، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
رابعا: المجلس الأكاديمي للجامعة
يتألف المجلس الأكاديمي من أعضاء ولجن يناط بهما التداول في المسائل المتعلقة بالجامعة وحسن سيرها؛[56]
أعضاء المجلس: يتألف المجلس من رئيس الجامعة رئيسا للمجلس؛ رؤساء المؤسسات الجامعية؛ مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛ مدير المركز الجهوي للاستثمار؛ المندوب الجهوي للتكوين المهني؛ وممثلين منتخبين من لدن ومن بين أساتذة الباحثين بالجامعة المعنية، يمثلون نظرائهم من جميع الأطر مع مراعاة النسبة العددية للتمثيل؛ ممثلين منتخبين من لدن ومن بين الموظفين الإداريين والتقنيين بالجامعة؛ ممثلين منتخبين من لدن ومن بين طلبة الجامعة يمثلون أسلاك التكوين؛[57]
لجان دائمة: يساعد المجلس في القيام بمهامه كل من لجان دائمة وهي: لجنة الشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية؛ لجنة البحث العلمي والابتكار؛ لجنة الشراكة والتعاون.
يتولى المجلس الأكاديمي القيام بمجموعة من المهام أغلبها اقتراحات وإبداء الآراء، لا سيما في مشاريع ذات الطابع البيداغوجي والمشاريع الخاصة بالبحث العلمي والتي يعرضها على رئيس الجامعة، وتتمثل أهم هذه الاختصاصات في إبداء الرأي في اقتراح مشروع ميزانية الجامعة، وإحداث المؤسسات والهياكل المشتركة للجامعية والمختبرات ومراكز البحث وغيرها من البنيات الأخرى التابعة للجامعة، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات الهادفة إلى إحداث أقطاب جامعية أو الانضمام إليها[58].
الفقرة الثانية: المؤسسات الجامعية العمومية
يتم إحداث كل مؤسسة جامعية بمرسوم يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليها في المادة 74 من هذا القانون، أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي المتخصصة فيتم إحداثها إما بموجب قانون في حالة مؤسسة عمومية، أو بموجب مرسوم في الحالات الأخرى، وذلك باقتراح من السلطة الحكومية المعنية، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.[59]
تضم كل مؤسسة جامعية عمومية مجلسا للتدبير ورئيسا، ولجان دائمة ومؤقتة، وشعبا مطابقة للتخصصات ولمجالات الدراسة والبحث، كما تضم مصالح خاصة بها ومراكز للتكوين والدراسة.
أولا: مجلس التدبير
يتألف مجلس تدبير المؤسسة الجامعية من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة والموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من أعضاء معينين من بين شخصيات من خارج المؤسسة.[60]يتداول في شؤون كل مؤسسة جامعية مجلس تدبير المؤسسة وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم، وكذا كيفية سيره بنص تنظيمي، وقد خولت له مجموعة من الاختصاصات بموجب هذا القانون، تحدث لديه لجان دائمة ومؤقتة إن اقتضى الحال ذلك، يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للمؤسسة.[61]
ثانيا: رئيس المؤسسة الجامعية
يسير الكليات والمدارس والمعاهد لمدة خمس سنوات[62]، قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة، عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشحات من بين أساتذة التعليم العالي. الذين يتقدمون ببرنامج عمل، متعدد السنوات، منسجما مع مشروع تطوير الجامعة.[63] يقوم رئيس المؤسسة بتسيير المؤسسة والإشراف على حسن سير مصالحها والمرافق التابعة لها، وتنسيق أنشطتها، كما يتولى مهاما أخرى، يساعده في ذلك نوابه يحدد عددهم وفق الهيكلة المعتمدة بالجامعة وكاتب عام للمؤسسة، يعينهم رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعني، يجوز لرئيس المؤسسة أن يفوض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى نوابه وإلى الكاتب العام[64].
ثالثا: هيئة رؤساء الجامعات وهيئة الأساتذة الباحثين
أعضاء هيئة رؤساء الجامعات: هي هيئة استشارية تتكون من رؤساء الجامعات العامة، تناط بها مهمة إبداء الرأي في القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي، وتقديم كل مقترح أو توصية من شأنه تحقيق أهداف إصلاح المنظومة وتطوير أدائها.
هيئة الأساتذة الباحثين: تتألف هيئة الأساتذة الباحثين العاملين بمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام من أساتذة باحثين دائمين، كما يمكن للمؤسسات أن تستعين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بأساتذة مشاركين أو زائرين أو عرضيين من أجل إنجاز بعض المهام الموكولة للأساتذة الباحثين والمرتبطة بالتكوين والتعليم والتقييم والتأطير.
واعملا لمبدأ الديمقراطية التشاركية والتنسيق مع الفاعلين، واعتبارا لأهمية تمثيل الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والطلبة في الهياكل الناظمة لحكامة مؤسسات التعليم العالي وبالأخص، الجامعات، ينبغي على المُشرِّع من خلال مرتكزات المشرُوع الجديد توسيع تمثيلية بعض الفئات منها، لا سيما الأطر الإدارية والتقنية لأهميتها ودورها الفعال في حلحلة مجموعة من المشاكل واحتوائها، وتنفيذ وتوجيه مقررات المجالس. نظرا لكون الموارد البشرية دعامة أساسية للرفع من أداء ومردودية الجامعة المغربية، يؤكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين في رأيه المتعلق بهذا المشروع، بأهمية التنصيص بمجموع أصناف الموارد البشرية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مع ضرورة، "إعداد نظام أساسي مندمج، ومحفز يدرج مجموع الفئات المهنية العاملة بالجامعات."[65]
خاتمة
في سبيل الختم لهذه الدراسة، يمكن القول أن وضعية الجامعات المغربية عرفت تحسنا ملموسا منذ بداية العمل بالقانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي عزز من استقلالية الجامعة وانفتاحها، عبر إشراك مجموعة من الفاعلين الخارجيين في تدبير مجالس الجامعات والمؤسسات التابعة لها، وأيضا من خلال توسيع واشتمال هذه المجالس على جميع تمثيلية الفئات الجامعية، وهذا ما لمسناه أيضا في مرتكزات مشروع قانون المرتبط بتنظيم التعليم العالي، الذي من خلاله وقفنا على آليات جديدة لتدبير الجامعة ومؤسساتها، وخاصة ما يتعلق باللامركزية واللاتمركز الجامعي، ومع ذلك هناك مجموعة من الجوانب والأعمال التي يتعين تحسينها وتفعيلها:
- تنزيل مبدأ الاستقلالية الجامعية، عبر تفعيل مجموعة من المقتضيات التي جاء بها القانون 01.00، على سبيل المثال لا الحصر المواد التالية (5، 7، 17، 18...)،
- تشجيع المشاركة في مجالس الجامعات عن طريق تحفيزات أو ربط تلك المشاركة بتطوير المسار المهني أو في تولي مناصب المسؤولية بالنسبة للأعضاء المنتخبين،
- خلق الإلتقائية والانسجام بين المشاريع والأهداف المحددة من طرف رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية،
- تسريع عملية تدبير الأنشطة الجامعية بالطرق المعلوماتية وخاصة ما يرتبط بمسألة التوقيع وتقديم الخدمات، مع ضرورة توفير جميع المستلزمات اللوجستيكية والمالية والبشرية لذلك،
- تفعيل آليات المراقبة والتقييم المنتظم الداخلي الخارجي للجامعات يغطي جميع الجوانب، عبر خلق مجموعة من اللجن والهيئات الوطنية والجهوية على الأقل،
- تسريع عملية تحديث الأنظمة الأساسية والنصوص القانونية والأطر المرجعية، والمنظام الإداري الجامعي، وكذا عمليات التقييم والتدقيق المعلن عنهم في الرؤية الاستراتيجية وقانون الإطار،
- جعل مجلس الإدارة الجامعية هيئة المراقبة والتقييم لرئيس الجامعة، ولأعمال مجلس الجامعة، وكل المجالس واللجن، ومجالس المؤسسات الجامعية، وليس كهيئة رئيسية في تدبير شؤون الجامعة،
- تحديد مهام واختصاصات، مجالس التدبير بدقة، مع إلزامية تقديم تقارير في هذا الشأن، وجعل الحضور إلزامي بالنسبة لأعضائه،
- فتح المجال أمام الموظفين الإداريين الذين قضوا مدة معتبرة في العمل الإداري لتولي مناصب مسؤولية المؤسسات الجامعية، بشرط التوفر على شهادة السلك الثاني أو الدكتوراه بدل أستاذ التعليم العالي،
- خلق خلايا للتواصل وحل الخلافات دخل المؤسسات الجامعية، إضافة إلى خلية التكوين في مجال التطور التكنولوجي والاتصال في هذه المؤسسات،
- نزع العمومية عن مقتضيات مشروع قانون التعليم العالي، والتفصيل أكثر في بعض مرتكزاته، مع ضرورة التنصيص على جميع فئات الموارد البشرية المتكونة منها الجامعة،
- التقليص من كثرة الإحالة على النصوص التنظيمية، من خلال تضمين تلك النصوص والمقتضيات في هذا مشروع،
- تفعيل عملية التقييم والمراقبة على المؤسسات الجامعية بشكل مستمر وموسمي،
- تسريع عملية إخراج الأنظمة الأساسية الخاصة، وقانون التعليم العالي الجديد، مع جميع النصوص القانونية التنظيمية المرتبطة به،
- تأهيل الموارد البشرية الجامعية مع توفير تكوينات ملائمة ومنتظمة، خاصة ما يرتبط بجانب المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي، مع تضمين مسألة الرقمنة في مقتضيات مشروع قانون التعليم العالي...
- أهم المصادر والمراجع المعتمدة
- الديوري محمد، حلم الجامعة المغربية المتكاملة، مطبعة جامعة مولاي إسماعيل_ مكناس، الطبعة الأولى أكتوبر 2023،
- ثرية أقصري، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وآليات تنزيلها، معارف تربوية، ع 3، (د.ت)، ص_ص 59_69.
- حسين العمراني، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، ضرورة تقوية القدرات التنظيمية، الجزء الأول والثاني، طبعة 1999، بمساهمة مؤسسة كونراد أد يناور،
- محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 1985، ط 1973، ص 10.
- الرسائل والأطروحات:
- إدريس فخور، إدارة شؤون الجامعات بالمغرب _قراءة في النظام القانوني وآليات التدبير الإداري_ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، السنة الجامعية 2012_2013،
- رسالتنا لنيل شهادة الماستر في القانون، تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية، الكلية متعددة التخصصات الرشيدية، جامعة مولاي إسماعيل_ مكناس، سنة 2024،
- عبد العزيز مهنون، هياكل التعليم العالي ومستجدات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بحث لنيل الماستر،2008-2009، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط-أكدال.
- المجلات والمقالات:
- صالح الدين كرزابي، عدي البشير، الجامعة وتحديات التنمية بالمغرب: مساهمة الخبرات في قضايا التنمية، مجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ع 3، ماي 2022،
- خفيف سعيد، تقييم أداء الجامعة التعلمية من خلال رقابة المجلس الأعلى للحسابات، مجلة القانون المغربي، العدد 39 يناير 2019،
- هشام الحسكة، الجامعة المغربية، بين إشكالية الأزمة وسياسة الإصلاح، مجلة العلوم القانونية_ سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، 2016، ع5.
- النصوص القانونية:
- ظهير شريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421(19 ماي 2000)، بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000،
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102، بتاريخ 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975)، يتعلق بتنظيم الجامعات، الجريدة الرسمية، ع 3252،
- مشروع القانون رقم 63.21 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 21 يونيو 2021.
- مرسوم رقم 2.04.89 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ج ر، عدد 5222،
- المرسوم رقم 2.01.2328 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كفية سيرها، ج.ر، ع 5016 (27 يونيو 2002)،
- المرسوم رقم 2.01.2327، المتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس تدبير الجامعة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5016 بتاريخ 27 يونيو 2002.
- التقارير:
- تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020،
- تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حكامة منظومة التربية والتكوين بالمغرب-قطاع التعليم العالي-سلسلة نصوص قانونية، ط1، 2017،
- تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مشروع نجاعة الأداء، مشروع قانون المالية لسنة 2016، نونبر 2015،
- التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، دجنبر 2014.
- المراجع الأجنبية
- Hicham Attouch, les Universités Marocaines à l’heure de la régionalisation avancée : essai d’évaluation de la gouvernance universitaire régionale, Revue marocaine d'audit et développement, n 33, 2012,
- Ahmed Ghouati, l’Enseignement Supérieur au Maroc : de l’Autonome a la Dépendance, Journal of Higher Education in Africa / Revue de l’enseignement supérieur en Afrique, 2010,
- Mohamed Abdouh, Relation formation- emploi et développement au Maroc : cas de l’enseignement supérieur, Revue Azaytouna des études juridiques et économiques, n 2, 2003,
- Report of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Towards and Arab Higher Education Space: International Challenges and Societal, Responsibilities, Proceedings of the Arab Regional, Cairo 31 May, 1-2 June 2009.
[1] Mohamed Abdouh, Relation formation- emploi et développement au Maroc : cas de l’enseignement supérieur, Revue Azaytouna des études juridiques et économiques, n 2, 2003, pp : 1-20.
[2] محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 1985، ط 1973، ص 10.
[3] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102، بتاريخ 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975)، يتعلق بتنظيم الجامعات، الجريدة الرسمية، ع 3252، ص 719.
[4] صالح الدين كرزابي، عدي البشير، الجامعة وتحديات التنمية بالمغرب: مساهمة الخبرات في قضايا التنمية، مجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ع 3، ماي 2022، ص 295.
[5] ظهير شريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421(19 ماي 2000)، بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 25 ماي 2000، ص: 1194.
[6] تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مشروع نجاعة الأداء، مشروع قانون المالية لسنة 2016، نونبر 2015.
[7] ثرية أقصري، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وآليات تنزيلها، معارف تربوية، ع 3، (د.ت)، ص_ص 59_69.
[8] صادر في 19 أغسطس 2019، الجريدة الرسمية، ع 6805، ص 5623.
[9]Ahmed Ghouati, l’Enseignement Supérieur au Maroc : de l’Autonome a la Dépendance, Journal of Higher Education in Africa / Revue de l’enseignement supérieur en Afrique, 2010, PP. 23-47.
[10] حسين العمراني، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، ضرورة تقوية القدرات التنظيمية، الجزء الأول، طبعة 1999، بمساهمة مؤسسة كونراد أد يناور، ص 38.
[11] هشام الحسكة، الجامعة المغربية، بين إشكالية الأزمة وسياسة الإصلاح، مجلة العلوم القانونية_ سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، 2016، ع5، ص _ص 137_167.
[12] Hicham Attouch, les Universités Marocaines à l’heure de la régionalisation avancée : essai d’évaluation de la gouvernance universitaire régionale, Revue marocaine d'audit et développement, n 33, 2012, p-p 241-258.
[13] الديوري محمد، حلم الجامعة المغربية المتكاملة، مطبعة جامعة مولاي إسماعيل_ مكناس، الطبعة الأولى أكتوبر 2023، ص9.
[14] المادتين 4 و5 من القانون 01.00.
[15] الفصل 16 من ظهير1975: الأعضاء بحكم القانون هم رئيس الجامعة، عمداء الكليات ومديري المدارس، مديري المعاهد المختصة، نواب عمداء الكليات ومساعدو مديري المدارس. بينما يتحدد الأعضاء المنتخبون في أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر وأستاذ مساعد، ومساعد عن كل مؤسسة ينتخبهم لمدة سنتين زملاؤهم من نفس السلك، طالبان عن كل مؤسسة ينتخبهما طلبة المؤسسة لمدة سنتين. أما المعينين فهم ثمانية أعضاء من خارج المؤسسة تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مما يجعلنا أمام فئتين لا غير، معينون ومنتخبون.
[16] بالنسبة للقطاعات الاقتصادية فقد خصص لها القانون خمسة ممثلين داخل مجلس الجامعة وتتوزع على رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، رئيس غرفة الفلاحة، رئيس غرفة الصناعة التقليدية، شخصين من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها رئيس غرفة الصيد البحري. أما القطاعات الاجتماعية فيمثلها ممثل عن النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين معين طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد اقتراح المكتب الوطني للنقابة، وممثل للتعليم العالي الخاص.
[17] تم استبعاد نواب العمداء ومساعدي مديري المدارس من عضوية مجلس الجامعة بحكم القانون، وفي المقابل تم إشراك مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وممثلي الهيئات الإدارية والتقنية في عضوية مجالس الجامعات والمؤسسات التابعة لها، وأيضا ممثلي القطاعات الاقتصادية، كما تم الحفاظ على نوعية الأعضاء القانونيين، المنتخبين، والمعينين.
[18] استعمل الظهير عبارة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ولم يستعمل وزارة التعليم العالي لأن التعليم كان يتّبع في بعض الأحيان لوزارة التربية الوطنية، وفي أحيان أخرى لوزارة خاصة، كما تم استبدال العبارة بالدولة في القانون 01.00.
[19] التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، دجنبر 2014، ص54.
[20] الجريدة الرسمية، عدد 5016، (27 يونيو 2002)، ص 1916.
[21] كذلك نفس الشيء في المادة 6 من المرسوم رقم 2.01.2328 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كفية سيرها، ج.ر، ع 5016 (27 يونيو 2002)، ص 1919.
[22] المادة 12: يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذه المادة والمواد الأخرى من هذا القانون 01.00، بينما يخول الصلاحيات الإدارية والمالية لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 9.
[23] نص الفصل 17 من الظهير على مهام الجامعة، والتي طغى عليها استعمال عبارة" إبداء الرأي " في أغلب الاختصاصات.
[24] الفصل 6 من ظهير 1975: يشرف على كل جامعة رئيس يعين بظهير من بين أساتذة الجامعة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ويساعده في ذلك كاتب عام وموظفون إداريون (ف 8)، ولم تكن مدة انتدابه محدودة. أما القانون 01.00 فهو لم يحدد طبيعة الأشخاص المؤهلين للترشح للمنصب، بل سكت عن الموضوع وجعل التعيين من حق كل من تقدم بمشروع خاص لتطوير الجامعة (المادة 15).
[25] عبد العزيز مهنون، هياكل التعليم العالي ومستجدات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بحث لنيل الماستر،2008-2009، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط-أكدال، ص70.
[26] المادتين 15 و16 من قانون التعليم العالي رقم 01.00، ص1197.
[27] المادة 9، من المرسوم رقم 2.01.2327، المتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس تدبير الجامعة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5016 بتاريخ 27 يونيو 2002، ص: 1918.
[28] المادة الأولى من المرسوم.
[29] إذا فقد عضو المجلس الصفة التي انتخب أو عين من أجلها أو استقال، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.
[30] إدريس فخور، إدارة شؤون الجامعات بالمغرب _قراءة في النظام القانوني وآليات التدبير الإداري_ أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، السنة الجامعية 2012_2013، ص 170.
[31] تنص المادة 152 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين على أن المجلس يقوم بتدبير الشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية والبحث العلمي بالجامعة.
[32] المادة 19 من الفصل الثاني، القانون 01.00.
[33] المادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.89 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ج ر، عدد 5222، ص.2644.
[34] المادة 20 من القانون 01.00: "تدرس وترتب الترشيحات والمشاريع من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة، وتعرض للدراسة على مجلس الجامعة الذي يقدم لهذه السلطة ثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا". وفي ظهير 1975 يعينون بظهير بناء على اقتراح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أو من بين الأشخاص ذوي الأهلية والكفاية في التكوين الجامعي دون الإشارة إلى تقديم ترشيحات والمشاريع.
[35] المادة 21 من الفصل الثاني، من القانون 01.00.
[36] المادة 1 من مرسوم رقم 2.01.2328 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)، بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفية سيرها، الجريدة الرسمية عدد 5016 الصادر في 27 يونيو 2002، ص 1919.
[37] تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، مرجع سابق، ص: 1523 وما بعدها. انظر أيضا تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حكامة منظومة التربية والتكوين بالمغرب-قطاع التعليم العالي-سلسلة نصوص قانونية، ط1، 2017، ص 23-43.
[38] التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، لسنوات 2000-2013، مرجع سابق، ص:54،
[39] تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2016، سعيد خفيف، تقييم أداء الجامعة التعليمية من خلال رقابة المجلس الأعلى للحسابات، مجلة القانون المغربي، العدد 39، يناير 2019، ص: 282.
[40] تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019-2020، مرجع سابق، ص: 1524.
[41] خفيف سعيد، تقييم أداء الجامعة التعلمية من خلال رقابة المجلس الأعلى للحسابات، مجلة القانون المغربي، العدد 39 يناير 2019 ص-ص 280-281
[42] PLAN NATIONAL D’ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION DE L’ECOSYSTEME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 2030.
[43] نمط جديد من المؤسسات تطرق إليها مشروع قانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مواده 13 و14، لكنها مؤسسات غير واضحة المعالم تحتاج إلى المزيد من التفصيل والتدقيق في مهامها وتوجهاتها التعليمية.
[44] مشروع القانون رقم 63.21 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 21 يونيو 2021.
[45] وصل عدد الطلبة في الموسم الجامعي 2022_2023، إلى (1.218.687) طالبا وطالبة موزعين على ثلاثة أصناف من مؤسسات التعليم العالي، مقابل عدد (36237) من الأطر الإدارية والبيداغوجية، بينما بلغ عدد الطلبة في مؤسسات التعليم الجامعي العمومي ب (1.095.868) أي ما يمثل (89،9) في المائة، مقابل (24400) من الأطر البيداغوجية والإدارية، أي ما يمثل (67،33) في المائة من العدد الإجمالي من هذه الأطر، للمزيد أنظر رسالتنا لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية العمومية، للموسم الجامعي 2023_2024، جامعة مولاي إسماعيل، كلية متعددة التخصصات الرشيدية.
[46] المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
[47] Report of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Towards and Arab Higher Education Space: International Challenges and Societal, Responsibilities, Proceedings of the Arab Regional, Conference on Higher Education, Cairo 31 May, 1-2 June 2009, P 30.
[48] المادة 22.
[49] يُنظر إلى هذا المجلس، أنه جسم غريب أقحم داخل الجامعة، نظرا لعدم تواجد أعضاء الجامعة والفاعلين الأساسين داخله، باستثناء رئيس الجامعة الذي يتميز حضوره بالصفة الاستشارية، وهذا يعطي انطباع عن تحول دور الجامعة في ممارسة مهامها واستقلاليتها، لا سيما أن رئيس هذا المجلس يعين بظهير.
[50] المادة 26 من مشروع القانون.
[51] المادة 29 من المشروع
[52] المواد 27 و28 من المشروع.
[53] كما يمارس رئيس الجامعة مجموعة من اختصاصات أخرى محددة في المادة 29 من هذا المشروع.
[54] المادة 33 من المشروع.
[55] المادة 32.
[56] تم تغيير اسم مجلس الجامعة، المنصوص عليه في المادة 9 من القانون 01.00، بالمجلس الأكاديمي للجامعة في المشروع.
[57] تم تغيير أعضاء هذا المجلس، بإضافة أعضاء جدد مدير المركز الجهوي للاستثمار، المندوب الجهوي للتكوين المهني، وإلغاء عضوية بعض الأعضاء، وإدخال البعض منهم في عضوية مجلس الإدارة رئيس الجهة، رئيس المجلس العلمي للجهة، رئيس المجموعة الحضرية أو رئيس المجلس الإقليمي ، سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من بين رؤساء الغرف المهنية وممثل واحد عن التعليم العالي الخاص، رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة، بالإضافة إلى تقليص عدد الممثلين المنتخبين من ثلاثة ممثلين إلى ممثلين عن كل فئة من المنتخبين.
[58] للمزيد أنظر رسالتنا لنيل شهادة الماستر في القانون، تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية، الكلية متعددة التخصصات الرشيدية، جامعة مولاي إسماعيل_ مكناس، سنة 2024، ص 29.
[59] المادة 10 من المشروع.
[60] يحدد تأليف مجلس تدبير المؤسسة وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم، وكذا كيفيات سيره بنص تنظيمي المادة 38 من المشروع. تم تغيير اسم مجلس المؤسسة باسم مجلس التدبير في هذا المشروع. تم تغيير اسم مجلس المؤسسة باسم مجلس التدبير وتم الاستغناء عن مجلس تدبير قديم.
[61] المادتين 39 و40.
[62] تم تمديد فترة رئاسة الجامعة وتسيير الكليات والمدارس والمعاهد من أربع سنوات إلى خمس سنوات.
[63] نفس شروط الترشيح المذكورة في المادة 20 من القانون رقم 01.00.
[64] تعرض المشاريع الخاصة بالمديرين والعمداء لتطوير المؤسسات الجامعية في القانون 01.00 فقط على لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية، والآن باتت تعرض في بداية الأمر على مجلس تدبير المؤسسة والذي بدوره يعرضه على رئيس الجامعة، وهذا الأخير ينظر في مدى ملاءمته ومطابقته مع مشروع تطوير الجامعة وترجمته ببرنامج عقد بين الجامعة والمؤسسة.
[65] رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول مشروع قانون رقم 63.21، يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رأي رقم 10/21، أكتوبر 2021، ص: 21.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 حكامة الجامعة العمومية، الآليات والوسائل - قراءة في مقتضيات قانون التعليم العالي 01.00، ومرتكزات مشروع القانون الجديد-
حكامة الجامعة العمومية، الآليات والوسائل - قراءة في مقتضيات قانون التعليم العالي 01.00، ومرتكزات مشروع القانون الجديد-