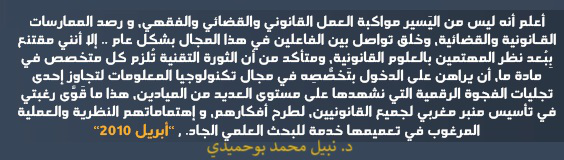نسخة مرفقة للتحميل

| Abstract: This study aims to explore the topic of hidden religiosity in Morocco, as it represents a point of intersection between various fields of knowledge such as religion, law, politics, and sociology. The focus of this study will be on the rights of individuals seeking to exercise their right to religious diversity, as well as an analysis of how authorities deal with these religious minorities and protect their freedom to practice their religious affairs, whether through national laws or international commitments as an active member of the international community. Key Words : RELIGION – RELIGIOSITY- FREDOM OF BELIEF-RELIGIOUS POLITICS |
مقدمة:
يُعَرف الدين بأنه منظومة التعاليم الإلهية التي تخاطب الإنسان على وجه التكليف، وبـأنه أيضا المزود الأساسي للعالم بالقيم والمُثل العليا، والمؤثر الرئيسي في تعاملات الأفراد؛ سواء مع بعضهم البعض كأفراد، أو بينهم وبين المؤسسات والجهات المكلفة بتدبير الشأن العام. أما التدين فيُعرف بأنه الكيفية التي يعيش بها الأفراد والجماعات تجاربهم الدينية عبر التفاعل مع كل أشكال الفهم والتطبيق للمكونات الأساسية لتلك التعاليم الإلهية، وتكييف الحياة بحسبها في التصور والسلوك. ومنه فماهية التدين تختلف تماما عن حقيقة الدين، من زاوية أن هذا الأخير هو نظام معياري لا يُفترض أن يطاله الخطأ، بينما التدين كسب إنساني في الاستجابة لتلك التعاليم، الشيء الذي يجعله عُرضة لإمكانية التحريف بالزيادة أو النقصان، سواء من خلال تأويل وفهم المتدين لأحكام وشرائع دينه وسلوكياته، أو من خلال طرق وكيفيات تنزيله لهذا الفهم على أرض الواقع. والتدين بهذا المعنى قد يكون موافقا للتوجه الرسمي من خلال تماهيه مع الثوابت الدينية للدولة، وبذلك يعتبر تدينا رسميا؛ ولا يجد المتتبع له حرجا في التشرُع به والتسنن بسننه في العلن وأمام المجتمع، بل وقد يحظى بحماية ودعم السلطات له في كل ما يتعلق بهذا النمط من التدين. وقد يكون أيضا خلافا لذلك تدينا لا ينسجم والهوية الدينية الرسمية، الشيء الذي يجعل من المتدينين به ولأسباب سوسيولوجية، سياسية وأمنية يضمرون معتقداتهم، أو في أحسن الأحوال يمارسونها بشكل خفي بعيد عن أعين ورقابة السلطات والمجتمع.في المغرب لا ينفك النظام السياسي يؤكد على دعمه وحماية لكل أنماط التدين الرسمي، سواء من خلال النصوص القانونية المؤطرة له، أو من خلال الخطاب السياسي للفاعل الديني الرسمي الذي صرح في أكثر من مناسبة؛ على أنه ومن مكانته الرمزية وصفته الدينية، مُؤتمن على حماية حقوق جميع المؤمنين بما فيهم اليهود المغاربة، والمسيحيين القادمين من الدول الأخرى الذين يعيشون في المغرب؛ الشيء الذي تم اعتباره من جهة مؤشرا على أن نطاق الحماية الدينية الرسمية، لا يطال إلا أتباع الديانات الإبراهيمية وتحديدا تلك المعترف بها من طرف السلطات، و من جهة ثانية فتح باب النقاش حول مسألة حرية المعتقد؛ وعبرها حقوق الأقليات الدينية بالمغرب أو ما يندرج في هذا المقال ضمن خانة التدين الخفي.
الإشكالية:
لا تقوم الديمقراطية على إقرار الدستور وإنشاء المؤسسات فقط، وإنما تقوم أيضا على التنظيم البنّاء والسليم للتنوع والاختلاف، فالدولة التي لا تدعم حقوق مختلف أفرادها؛ تساهم في ظهور مظاهر الصراع والتعصّب، في حين أن التي تتمسك بقيم الحرية والمساواة، تنجح في ترسيخ قيم والتعايش والاندماج داخل الوطن.
من هذا المنطلق يثار السؤال الإشكالي حول كيفية تدبير السلطات لمسألة التنوع الديني الخفي، من خلال تسليط الضوء عن الآليات والاستراتيجيات المعتمدة لتدبيره وفق الشكل التالي:
كيف قامت السلطات بتدبير مسألة التدين الخفي، وضمان حق مختلف أنماطه الدينية؟
ويتفرع عن هذا السؤال الإشكالي ما يلي من أسئلة فرعية:
- هل يمكن الحديث عن وجود تنوع ديني خفي في مجتمع تدين غالبيته بالدين الرسمي؟ ثم إذا كان كذلك فما هي تلاوين وأنماط هذا المشهد الديني؟
- كيف تعاملت السلطات مع مسألة التدين الخفي، وما هي الآليات والاستراتيجيات التي اعتمدتها في تدبيره؟
الفقرة الأولى: أنماط التدين الخفي
تتشكل خارطة التدين الخفي بالمغرب على الأقل من أربع أنماط دينية، يمكن الحديث عنها وفق مستويين: الأول مرتبط بأنماط اختارت أن تتبع معتقدا مخالفا للتوجه الرسمي، (الفرع الأول) أما الثاني فمرتبط بجماعات دينية تبنت توجها مذهبيا غير ذلك الذي تعلنه السلطات مذهبا لها (الفرع الثاني).الفرع الأول: التدين العقدي الخفي
يندرج ضمن هذا الإطار؛ مجموع الطوائف والجماعات التي تبنت معتقدا دينيا مخالفا للتوجه الرسمي، كالجامعة البهائية بالمغرب، (أولا) أو كحال المغاربة الذين غيروا دينهم عن طواعية وأضحو على ملة النبي عيسى عليه السلام.أولا: البهائيون المغاربة
يُعرف البهائيون المغاربة أنفسهم بأنهم جماعة من الأفراد المنحدرين من مختلف الطبقات والمستويات الاجتماعية المغربية،[1] انجذبوا روحيا إلى رسالة ''بهاءُ الله'' والتزموا برؤاه و اقتفوا هديه وامنوا برسالته.[2].تزامن تاريخ ظهور البهائيين في المغرب مع مجيء بعض العائلات البهائية المهاجرة من مناطق مختلفة كمصر وسوريا وإيران لاستقرار في المغرب خمسينيات القرن الماضي، وفي إطار تفاعلهم التلقائي مع هؤلاء الوافدين الجدد برزت إلى الوجود تباشير النواة الأولى للجامعة البهائية المغربية، والتي مرت بمرحلتين:
مرحلة التضييق حيث عانوا فيها جملة من المضايقات والاعتقالات والمضايقات انتهت بإدانة وسجن بعضهم، وطرد البعض الآخر من عملهم.[3] وذلك لتزامن ظهورهم وجهرهم باعتناق هذا الدين الجديد مع بداية بناء الدولة المغربية الحديثة، وفي ظروف كهذه، كان من الطبيعي النظر بنوع من الشك والارتياب لكل ما هو غريب عن الثقافة والاعتقاد السائدين في البلد.
مرحلة التعايش: بدأت مع دخول الألفية الثالثة، وكانت مرحلة متميزة من حيث الحقوق والحريات، أصبح فيها البهائيون ينتمون لمختلف الطبقات والمستويات الاجتماعية. وكجزء لا يتجزأ من هذا المسار شاركوا أصدقاءهم ومعارفهم تعاليم دينهم الداعية إلى خدمة المجتمع، في جو من التعايش والألفة مع المجتمع الأوسع الذي يحتضنهم.[4] الشيء الذي نتج عنه بروز أسماء بهائية داخل المجتمع من خلال كتاباتهم ومساهماتهم الفكرية، من غير أن يسيء إليهم أو يتعرض لهم أحد بالأذى.[5]
ثانيا: المسيحيون المغاربة
يعرف المسيحيون المغاربة أنفسهم بكونهم جماعة من المؤمنين المغاربة الذين اعتنقوا الدين المسيحي بشكل اختياري، من غير أن يخضع إيمانهم بالمسيح، لأي ضغط أو إغراء مادي أو اجتماعي، بل هو إيمان نابع من قناعات دينية محضة.[6] وهم على هذا الأساس يعتبرون أنفسهم مؤمنين مغاربة من مشمولات إمارة المؤمنين، يستندون في شرعنة وجودهم من جهة على التصريح الذي وسّع خلاله أمير المؤمنين من مشمولات رعاياها إلى جميع أتباع الأديان الإبراهيمية.[7] كما يستندون من جهة أخرى على متكئات حقوقية من أهمها رمزية الاجتماع الذي خصهم به رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أبريل من سنة 2017.[8]ينتظم المسيحيون المغاربة في تجمعات مؤسسية متنوعة،[9] ويتوزعون جغرافيا في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وطنجة.[10] وتتضارب الآراء حول عددهم وفق مقاربتين: الأولى رسمية، والثانية غير رسمية.
بالنسبة للأولى؛ ليست هناك إحصائيات رسمية ولا أرقام مضبوطة عنها على الرغم من الاعتراف الرسمي بوجود حركات تنصيرية تنشط فوق التراب المغربي،[11] أمَّا الجانب غير الرسمي؛ فقد أشارت بعض الصحف المغربية إلى وجود حوالي 7000 متنصر مغربي، في حين أشارت مصادر أخرى إلى 58 ألف مغربي تنصَّر.[12] أما التقرير الحالة الدينية لوزارة الخارجية الأمريكية فقد قَدّرهم في حوالي 31500 متنصر.[13]
لفرع الثاني: التدين المذهبي الخفي
نقصد بالتنوع المذهبي مجموع الأقليات الدينية التي تبنت مذهبا فقهيا لا يدخل ضمن خانة المذاهب الممنوعة من طرف السلطات، كالجماعة الإسلامية الأحمدية، التي بالإضافة إلى أنها جماعة تؤمن بالرسالة الإسلامية، لديها اعتقاد راسخ باستمرارية الرسالة وعدم انقطاع الوحي الإلهي. (أولا) ويقصد به أيضا حتى الجماعات التي آمنت بمذهب ديني/سياسي تعتبره السلطات يشكل تهديدا لأمنها الروحي المذهبي كحالة المتشيعين المغاربة. (ثانيا)أولا: الأحمديون المغاربة
تُعرف الجماعة الإسلامية الأحمدية[14] نفسها -وفق الوثائق الفكرية والتأسيسية الرسمية- بأنها الجماعة الإسلامية التجديدية العالمية، والنشأة الثانية الموعودة للإسلام. وقد مرت في إطار تواجدها بالمغرب؛ شأنها شأن جميع أنماط التدين غير الرسمي بمراحل ومحطات تاريخية مختلفة، بدأت إرهاصاتها الأولى في عهد المؤسس ميرزا ''غلام أحمد'' الإمام المهدي والمسيح الموعود، في ثلاثينيات القرن الماضي.[15] لكن الاعتراف بدخول الفكر الأحمدي بشكل رسمي إلى المغرب جاء عقب إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2013 عن اكتشاف حوالي 500 أحمدي في المغرب،[16] منتشرين في العديد من المراكز الدراسية، بكل من مدينة سلا الدار لبيضاء مكناس وطنجة .[17]أما عن كيفية دخولهم إلى المغرب؛ وبحسب تصريح زعيمهم بالمغرب، فالأحمدية بدأت بالدخول إلى المغرب عبر قناة فضائية اسمها "MTA3 العربية"، حيث شاهدها، وتأثر بها الكثير من المغاربة، و لعبت دورا مهما في الوساطة بين فكر وفلسفة الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبين الأعضاء المغاربة الجدد.[18]
| تتميز الجماعة الإسلامية الأحمدية بازدواجية المواقف إزاء موضوع البيعة؛ يقول دائما ''عصام الخمسي'' زعيم الجماعة الإسلامية الأحمدية بالمغرب في تفسير ازدواجية ارتباطهم ببيعة أحمدية، وأخرى مغربية في ذات الآن؛ بأنه ''ليس هناك أي تعارض بين ما تدعو إليه الجماعة الأحمدية، وما تقوم عليه إمارة المؤمنين بالمغرب، فولائهم للميرزا ''أحمد غلام'' ولاء روحي ديني، بينما بيعتهم لأمير المؤمنين بيعة سياسية، بيعة على الطاعة والامتثال للقانون، ولقد صرح جلالته خلال زيارته لمدغشقر بأنه أمير لجميع المؤمنين المغاربة.[19] ونحن في الجماعة الأحمدية نعتبر أنفسنا مسلمين ومؤمنين، وشرف لنا أن يجعلنا جلالة الملك تحت إمرته.[20] فضلا على أننا جماعة دينية لا تهدف إلى أية مرام سياسية، وبالتالي فبيعتُنا مجردة من أي سعي وراء الحكم والسلطة،[21] وبذلك فهي لا تتعارض مع بيعتنا للملك محمد السادس، فنحن نعلم أن ما فرّق الأمة الإسلامية هو استغلال الدين في السياسة. بينما الدين الإسلامي شريعة المجتمع، ودعوة إلى سبيل الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. |
ثانيا: المتشيعون المغاربة
تضاربت الآراء حول سياق وعوامل ظهور التشيع بالمغرب؛ بين من يرى تجذر وعمق التشيع بالمغرب،[22] وبين من يرى حداثة الظاهرة وارتباطها فقط بنجاح الثورة الإيرانية ومحاولة تصدير تجربتها إلى باقي الدول العربية ومنها المغرب.[23] وعموما يمكن رصد تاريخ الحضور الشيعي في المغرب وفق مرحلتين:مرحلة الحضور الاجتماعي: تسرب خلالها التشيع من طريقين: الأولى عبر استقدام رجال التعليم من المشرق لملء الخصاص الذي خلفه مغادرة الكوادر التعليمية الأجنبية، أما الثانية: فيرجح أن التشيع قد نفذ خلالها من زاوية السياحة بشكل عام والسياحة السعودية بشكل خاص.[24]
مرحلة الحضور السياسي: في هذ الإطار يمكن الحديث على حضور سياسي شيعي متذبذب، توافق تام في فترة حكم الشاه ''محمد رضا بهلوي''، إلى درجة أن تم وصفها على أنها علاقة وطيدة بين مملكتين عريقتين تربطهما علاقة شخصية.[25] ثم نفور جاء نتيجة نجاح الثورة الإيرانية والصدى الكبير الذي أحدثته في العالم الإسلامي،[26] والذي شكل سببا لبروز توترات بين إيران الشيعية والمغرب السني، وصلت حد قطع العلاقات الدبلوماسية الثنائية.[27]
يتوزع المتشيعون المغاربة[28] بالرغم من محاولتهم الظهور بنوع من الوحدة والتجانس على مجموعة من الأنماط الدينية التي تختلف بحسب مبادئها ودرجة تشددها، بما يمكنه إجماله في اتجاهين:
1.تيار متشدد: يندرج في إطاره الشيرازيون[29] وهم من أكثر التيارات الشيعية تشددا في المغرب، ويتمظهر تطرفهم من جهة في إعادة إنتاج سلوك الطعن في الصحابة، بينما يتمظهر من جهة ثانية في تبديع كل ما يخالف العقيدة الشيعية من قبيل ولاية الفقيه والدعوة إلى التقريب بين المذاهب.[30] ينقسم أنصار هذا التيار إلى فئة لا تخفي مناصرتها للشيخ الشيعي الكويتي المثير للجدل ''ياسر الحبيب''، وفئة ثانية متبعة لمرجعية ''محمد الشيرازي'' والذي يُقدَّم نفسه باعتباره اتجاها معتدلا من داخل هذا التيار.
2.تيار معتدل: يندرج في إطاره مجموعة من التفرعات الشيعية لعل أهمها التيار الرسالي الذي يعد من أبرز التعبيرات الشيعية مرونة في الخريطة الشيعية، وأكثرها انفتاحا على المذهب السني، من أبرز قياداته على المستوى الوطني، ''كمال الغزالي'' و ''عصام حميدان''. كما يندرج فيه أيضا التيار الخامنئي[31] الذي يُوصف بكونه تيار حماسي وذلك لكون أنشطته تنحصر في عمومها في العالم الافتراضي، من خلال مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، عبر المجموعات والصفحات التي يتم تأسيسها بغرض النقاش العقدي، وبسبب تقاطع مرجعية هذا التيار الشيعي مع القيادة السياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتحاشى أتباع عذا التيار الظهور الإعلامي، وإشهار وجودهم بشكل علني[32] كما يعتبر التيار السيستاني،[33] أيضا من ضمن التيارات الشيعية المعتدلة وإن كان هذا الأخير من أكثر المرجعيات ضعفا من حيث الحضور، فضلا عن عدم وجود أي إطار تنظيمي خاص به.
الفقرة الثانية: أدوات ومستويات تدبير التدين الخفي
لا شك أن تعدد أنماط التدين غير الرسمي في المغرب اقتضى من معتنقيه تعددا في وسائل وآليات تدبير أمورهم الدينية، حتى وإن كان ذلك يتم بطريقة خفية (الفرع الأول) الشيء الذي فرض على السلطات تبني استراتيجيات متنوعة في طرق تعاملها معهم بحسب درجة تهديد كل نمط ديني لأمنها الروحي (الفرع الثاني).الفرع الأول: أدوات تدبير التدين الخفي
يقصد بأدوات تدبير التدين الخفي مجموع القنوات والنوافذ الدينية غير الرسمية التي تدبر من خلالها الطوائف أو الجماعات شؤونها الدينية بكيفية غير رسمية، والتي يمكن تقسيمها إلى أدوات تدبير عقدية(أولا) وآليات تدبيرية أخرى مذهبية(ثانيا).أولا: نوافذ تدبير التنوع الديني العقدي
في هذا الصدد يمكن التمييز بين مستويين، الأول خاص بكيفية تدبير الشؤون الدينية للبهائيين المغاربة باعتبارهم يعتبرون أنفسهم أتباع دين جديد، والثاني مرتبط بكيفية تدبير الحياة الدينية للمغاربة المسيحيين، أو ما أسميناهم تجاوزا في هذه الدراسة بالمتنصرين المغاربة تمييزا لهم عن المسيحيين الأجانب.- النظام الإداري البهائي
في المغرب ما يزال البهائيون يفتقرون إلى إطار تنظيمي رسمي، يمثلهم تمثيلا قانونيا أمام الأجهزة الرسمية، بالرغم من انتخابهم الدوري لمحافل روحانية تدير شؤونهم الدينية،[35] حيث إنهم وإن كانوا ينتخبون سنويا أعضاء يمثلونهم سواء على الصعيد المحلي أو المركزي.[36] إلا أن استمرار غياب إطار قانوني تنضوي تحته هذه المحافل، مثل الجمعية البهائية الفرنسية التي تمثل الإطار القانوني للمحفل الروحاني المركزي للبهائيين في فرنسا، يشكل عائقا أمامهم من أجل التمتع بجميع حقوقهم الدينية على أكمل وجه مثلما يضمنه لهم القانون في بلدان أخرى.[37]
- الكنائس المنزلية
ثانيا: أدوات تدبير التنوع الديني المذهبي
يمارس الأحمديون، والشيعة المغاربة، شؤونهم الدينية بطريقة متباينة، فالطائفة الأولى لا تجد حرجا في أن تعلن عن انتمائها المذهبي، وحجتها في ذلك أنها جماعة إسلامية، ليست لها أي مطامح سياسوية، في حين تعتبر التقية هي الحاجب والستار الشرعي الذي يتدثر به المتشيعون المغاربة، حماية لحقهم في التنوع الديني، وممارسته بعيدا عن كل ضروب المضايقات الرسمية.- الجماعة الإسلامية الأحمدية
محليا لا يتوفر الأحمديون المغاربة على إطار مؤسسي روحي يدبر شؤونهم الدينية؛ يقول زعيم الجماعة الإسلامية الأحمدية بالمغرب أنه بسبب التضيق الذي يطالهم من طرف السلطات، فإن عملية تدبير شؤونهم الدينية تتم بطريقة غير مباشرة،[42] خاصة عبر الجهود الذاتية، التي يبدلها الأعضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر أفكار الجماعة والإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بالفكر الأحمدي، في مجموعة من الملتقيات التي تم إحداثها خصيصا لهذا الغرض” كملتقى المسلمين الأحمديين المغاربة.[43]
تراتبيا، يخضع الأحمديون المغاربة لإمرة زعيمهم، الذي بدوره تم تعيينه من طرف الخليفة المركزي لرعاية شؤون الطائفة الأحمدية بالمغرب. يقول السيد ''عصام الخامسي'' في هذا الصدد: ''تتوفر الجماعة الأحمدية بالمغرب على هيكلة تنظيمية، لكن السلطات المغربية لا تعترف بنا كتنظيم اسمه الجماعة الإسلامية الأحمدية، بالرغم من محاولاتنا لتسجيل هذا التنظيم، تحت قانون الحريات العامةـ حيث جربنا اسم "أنوار الأحمدية" ثم اسم "منتدى الحوار والتواصلي"، لكن للأسف لم يتم التجاوب مع مطالبنا في هذا الملف.[44] بالرغم من المجهود الذي بدلناه للتعريف بقضيتنا.[45]
2- المجالس الشيعية: حسينيات مع وقف التنفيذ
سبق معنا أن الشيعة المغاربة لا يشكلون كتلة تنظيمية متجانسة،[46] وتبعا لذلك فإنهم، وإن كانوا يخضعون في إطار تدبير شؤونهم الدينية إلى روافد فقهية متباينة، إلا أنها جميعها تصب في مصب واحد، ألا وهو خدمة المذهب الجعفري الإثني عشري.[47] فضلا على أنها ترتكز جميعها على أحد أهم المفاهيم المركزية في الخطاب الشيعي ألا وهو مرتكز التقية،[48] الشيء الذي يصعب معه تحديد آليات تدبيرهم لأمور عقيدتهم بشكل دقيق، ولكن ذلك لا يمنع من الحديث عن آلية من الآليات السرية، التي يحاول شيعة المغرب من خلالها تنظيم أمورهم الدينية، ألا وهي آلية المجالس المنزلية أو ما يعرف في الثقافة الشيعية بالحُسينيات، وهي عبارة عن أماكن يجتمع فيها الشيعة في المناسبات الرمزية، لتدارس ومناقشة شؤونهم الدينية، وهي بذلك تكتسي أهمية كبيرة، إذ تعتبر من أنشط الأماكن المقدسة في الفكر الشيعي بعد المساجد،[49] بحيث تضطلع بوظائف دينية محورية، حيث يجتمعون فيها لإقامة مجالس العزاء الحُسيني، وقراءة الأدعية والأنشطة الدينية والثقافية الأخرى، بما يُمَكن من تعزيز أواصر التآلف والمحبة بين قلوب الشيعة.[50]
في المغرب تتضارب الآراء حول ماهية ودور الحسينيات الشيعية بين من ينفي وجودها أصلا،[51] وبين من لا يرى الحاجة إليها على الأقل في الوقت الحاضر،[52] وبين من يثمن الدور الذي تقوم به، بحيث يعتبرها نافذة دينية تتيح للشيعة المغاربة تجديد محبتهم وإيمانهم بآل البيت عبر قراءة القرآن، والأدعية الشيعية المأثورة، فضلا على القيام بجلسات دينية وفكرية متنوعة، بهدف تدارس كل ما يتعلق بالشأن الديني الشيعي المغربي، وسبل تدبيره بكيفية ناعمة بعيدة عن أعين السلطة ورقابة المجتمع.[53]
الفرع الثاني: استراتيجيات تدبير التنوع الديني
لا شك أن تنوع أنماط التدين الخفي بالمغرب، فرض على السلطات تنويع مقارباتها التدبيرية، ومستويات تعاطيها مع هذه الأنماط الدينية، وذلك ارتباطا بتوافر عاملين أساسيين وجودا وعدما، الأول يتعلق بحجم تهديد هذا التيار الديني للاستقرار الروحي للمجتمع، الشيء يستدعي تشديد الخناق على كل أنشطته ومحاصرته.[54] وثانيهما شعبية وقوة تجدر هذا التيار في النسيج المجتمعي، فكلما كان حضوره ضعيفا تم تجاهله، والعكس صحيح.أولا: استراتيجية التضييق والمحاصرة:
يستعمل هذا النوع من الاستراتيجيات إما ضد التيارات الدينية التي تنطلق في مرجعياتها الفكرية من قناعات مخالفة للثوابت الدينية للدولة، أو ضد تلك التي تناور حسب الظروف السياسية، لنسف الخصوصية الدينية وضرب أسس ومقومات النظام. ويتحدد الهدف من عملية التضييق والمحاصرة هذه، في محاولة التأثير في هذا النوع من التيارات الدينية، بُغية تليين مواقفها السياسية، وقناعاتها الفكرية، حتى تغدو أكثر مرونة واعتدالا في علاقاتها مع نظام الحكم، وجعلها تُقر بشرعيته السياسية والدينية. ولقد تم اعتماد هذه التقنية -بنوع من المرونة- مع المكون الشيعي المغربي، فمن جهة، ثم التضييق عليه، واتهامه بكونه ينهل من منظومة متشددة، عبر التأثر بأدبيات ''الإمام الخميني'' و ''محمد حسين فضل الله'' التي تسيئ إلى المقومات الدينية الجوهرية للمملكة، وتسعى إلى المس بالهوية الراسخة للشعب المغربي، ووحدة عقيدته، ومذهبه السني المالكي،[55] الشيء الذي يشكل خرقا مباشرا للمبادئ الأساسية للأمة المغربية والتي لطالما أكدت عليها السلطة السياسية، والتي جعلتها نظارة تنظر من خلالها لكيفية تعاملها مع مثل هذه الأنماط الدينية.[56]ومن جهة أخرى، ثم ترك باب الاندماج المجتمعي مواربا لجميع مكوناته عبر التغاضي عن قيامهم بعض الأنشطة الشيعية، التي لا تتعارض أو تمس بثوابته الدينية، كالسماح لهم بتنظيم زيارة رسمية لضريح المولى إدريس، بمناسبة تخليد ذكرى عاشوراء، بالرغم مما تحمله هذه الذكرى من أبعاد ودلالات شيعية، أو من خلال السماح لهم بتشييع جثمان الشيخ " عبد الله الدهدوه" بمدينة طنجة، المعروف بتأثره بمرجعية "على خامنئي" وفق الطقوس الشيعية.[57]
ثانيا: استراتيجية التجاهل واللامبالاة:
وهي استراتيجية تعتمدها السلطة السياسية تجاه بعض التيارات الدينية، التي لا تشكل في نظرها أي خطورة دينية أو سياسية، ولا تحظى بأي تجذر أو سند جماهيري، نظرا لطابعها النخبوي، وهو ما يمثله في مقالتنا هذه نموذجي الجماعة الإسلامية الأحمدية، والجامعة المغربية البهائية. فالجماعة الإسلامية الأحمدية لا تحظى بالاعتراف الرسمي من طرف السلطات بالرغم من قيامها بعدة محاولات لتسجيل تنظيمها عبر قانون الحريات العامة.[58] كما أنها لا تشكل أي تهديد عليه، على اعتبار أنها تعتبر نفسها جماعة من المغاربة المسلمين المؤمنين، المعترفين بإمارة المؤمنين والمحتمين بظلها، ولا تجد حرجا في أن تقدم لها أواصر البيعة على الطاعة والامتثال للقانون.[59]أما البهائيين وبالرغم من التطبيع شبه الرسمي الحاصل في التعامل معهم، سواء تعلق الأمر بالسلطات الأمنية، أو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو ببعض المنابر الإعلامية،[60] إلا أنهم مازالوا يفتقرون إلى إطار تنظيمي يمثلهم تمثيلا قانونيا، بالرغم من أنهم يَنتخبون سنويا محافل روحانية تدير شؤونهم الدينية، والاجتماعية، على المستويين المحلي والمركزي، كما أنهم لا يسعون، ولا يهدفون أبدا، إلى الوصول إلى السلطة أو التشكيك في مشروعيها، فعقيدتهم قائمة على فكرة التمييز بين السياسة العمومية التي يشجعون أعضائهم على المشاركة فيها من أجل المساهمة في التنمية المحلية، وبين السياسة الحزبية التي ينأون بأنفسهم عنها، بحكم أنها قائمة على التنافس والسعي حول السلطة.[61]
إن وجود هذه الإستراتيجيات التي تشكل طريقة تعامل السلطات المغربية مع مختلف التيارات الدينية، لا يعني أن كل استراتيجية تُستعمل بشكل مستقل، ومنعزل عن باقي الاستراتيجيات الأخرى، بل إن طبيعة وموازين القوى الدينية، ونوعية العلاقات التي تربطها بالسلطة، هي التي تحدد نوع المقاربة والاستراتيجية المعتمدة، فمثلا يمكن استعمال استراتيجية الإدماج وبالموازاة معها، تستعمل استراتيجية التجاهل، أو الردع، كل ما انزاحت إحدى هده القوى عن الخط الديني الرسمي للدولة، وبالمقابل يمكنه أن الاستعانة باستراتيجية التضييق والمحاصرة، أو استراتيجية التجاهل واللامبالاة، أو استراتيجية الشدة والردع، ضد التيارات التي تبدو متشددة.
خاتمة:
لا شك أن قناعات الناس في اختيار انماط التدين تختلف وتتفاوت من شخص إلى آخر، فهي ليست بمعزل عن سياق التطور الإنساني، وإنما هي رهينة الظروف والأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، التي تعيشها الفئات الاجتماعية، والتي تنعكس على أنماط تدينها وأشكال تمثلها لقيم ومبادئ دينها.ومنه فإن السعي إلى حماية حق هذه الفئات من التدين غير الرسمي لا يمكن أن يتم إلا عن طريق تعزيز الاحترام والتسامح والتعايش السلمي بين الأديان. وكذا تكريس الوعي بأهمية احترام الحقوق والحريات الدينية، والقيم المشتركة بين الأديان، فضلا على تبني مبادرات تربوية تعزز التعايش السلمي، عبر تضمين هذه القضايا في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، إضافة إلى دعم القوانين والسياسات التي تحمي وتكفل حقوق الأقليات الدينية التي لا تدين بالدين الرسمي للدولة، وفق قواعد متينة لبناء إرادة جماعية، وهوية وطنية موحدة، تھيكلها روابط قانونية واضحة، لتعاقد مؤسسي يروم التمساك الاجتماعي الموحد، ويستحضر بنود العقد الاجتماعي، الُمفتَرض أن يؤطر علاقة الدولة بالمجموعات الاجتماعية والسياسية من جھة، وعلاقاتھا بالمواطنين من مختلف التوجهات الدينية من جهة أخرى، وطبعا لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا عبر تبني وتكريس فلسفة التعايش والتعدد وقيم المواطنة، كقواعد ھيكلية لمجتمع يحتكم إلى مبادئ الحق والواجب والقانون، وآليات رسمية فاعلة وقادرة على تنزيل مضامين الدستور، التي تمكن جميع مكونات المجتمع المغربي، من التعايش والتلاقح والانفتاح بما يتماشى مع صورة الإنسان، وصورة المجتمع، كما يتطلع إليها المغاربة قاطبة، وذلك وفق التدابير التالية:
-التدبير البيداغوجي: وذلك بإعادة توظيف المدرسة والجامعة عبر سياسة تعليمية جديدة متعددة الأبعاد(Multidimensionnel)؛ قادرة على تكوين إنسان منفتح ومتفهم، تنصهر في شخصه السِّمات المتنوعة، بتمظهراتها الدينية والثقافية والقيمية، بما في ذلك مجمل المعطيات المستخلصة من الروافد المنصوص عليها في الدستور، كسبيل لتكريس وحدة وطنية، جماعية، بما يحاكي ذلك الصهر الكيمائي لعدة عناصر متنوعة ومتباينة في منتوج واحد.
الحوار المؤسسي: الذي يتأتى من مستخلصات حوارات عمومية ديموقراطية، تقضي على جميع أشكال التعصب الديني، والنعرات الطائفية، المتأتية من خطابات دينية في غير سياقها، أو ترويج آراء؛ أو فتاوى تسبب الجدل، والاحتقان المجتمعي، بين مختلف مكونات النسيج الديني، في أفق أن تبني تفكير جماعي مرتكز على المصلحة العامة الجامعة، وفق منهج عقلاني يُقِر بحق الاختلاف والتنوع الدينيين، بُغية الوصول إلى توافقات ومخرجات تكفل حق مختلف أنماط التنوع الديني، بما يحقق التماسك الاجتماعي، الكفيل باستتباب السلم الوطني، والمحقق للتوازنات الاجتماعية.
لائحة المصادر والمراجع والمواقع:
- الحسين، الزاوي، المغرب العربي وإيران.. تحديات التاريخ وتقلبات الجغرافيا السياسية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، يناير (كانون الثاني) 2011.
- أحمد مرزا غلام: فتح الإسلام، توضيح المرام، إزالة الأوهام، ترجمة عبد المجيد عامر، ج3، ط 2 2015.
- إدريس هاني: المغرب والتشييع- أية علاقة؟ مجلة وجهة نظر، العدد: 39 لسنة 2009.
- حسن أشرف الغزالي: الترخيص لمساجد خاصة بالشيعة "ممكن" حوار بتاريخ 2 نونبر 2015 منشور في موقع الخط الرسالي.
- عبد الرحيم الشرقاوي: مقابلة مع زعيم الجماعة الإسلامية الأحمدية، منشورة على موقع أصوات مغربية.
- عمر النجار: القاديانية، مجد المؤسسة للدراسات والنشر و للتوزيع، بيروت، 2005.
- عبد الحكيم أبو اللوز: تحولات الموقف المغربي الرسمي من التشييع (2014-1981)، مركز المسبار للدراسات والبحوث، يونيو 2016.
- علاء عبد الرزاق مطلك: الديانة البهائية في العالم: تاريخها، تعاليمهاـ وعلاقتها بإسرائيل، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، العدد السادس، يناير 2007.
- محمد ضريف: الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط1، 2017.
- محمد السروتي: تساؤل عن الجهود الرسمية لمواجهة ظاهرة التنصير - المغرب أنموذجا، الألوكة.
- محمد قنفودي: إرهاصات تسييس الشيعة المغاربة: حذر الدولة ورغبة الانفتاح السياسي، المعهد المغربي لتحليل السياسات، 2018.
- محمد اليوبي: المسيحيون المغاربة.. من هم؟ وكيف يعيشون؟ جريدة المساء، عدد 23 دجنبر 2015.
- رضوان مبشور: حوار مع زعيم الأحمديين المغاربة، مقال منشور في جريدة الأيام 24، بتاريخ19 دجنبر 2017، تاريخ الاطلاع يناير 2022.
- سكينة بنزين: مغاربة يعتنقون الأحمدية، جريدة الأحداث المغربية في 30 دجنبر 2016.
- رشيد مقتدر: الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى 2010.
- ياسين أروين: القاديانية تغزو المغرب ووزارة الأوقاف تدق ناقوس الخطر، مقال منشور في شبكة أندلس الإخبارية بتاريخ 18 نونبر 2013.
الهوامش
[1] بلغ عدد البهائيين المغاربة وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2021 ما بين 350 و400، متفرقين في أنحاء البلاد.
[2] من نحن / نبذة تاريخية عن البهائيين المغاربة، من البوابة الرسمية للجامعة البهائية المغربية.
[3] يشير الأستاذ محمد ضريف إلى أن محاكمة البهائيين سنة 1984 بمدينة المحمدية، لم تكن على أساس الردة أو بسبب تغيير المعتقد، وإنما كانت المتابعة بتهمة تلقي أموال بطريقة عير قانونية من جهات أجنبية، كما أن عملية الطرد شملت عناصر تنتمي إلى السلك العسكري الذي ينبغي أن يتصف بالحياد وأن لا يدين بالولاء إلا للملك. محمد ضريف: الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط1، 2017، ص44.
[4] يفرق البهائيون المغاربة الذي بلغ عددهم وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2021 ما بين 350 و400، عضوا متفرقين في أنحاء البلاد. بين السياسة العمومية والسياسة الحزبية، فيشجعون أعضائهم على الأولى من أجل المساهمة في التنمية المحلية، وينأون بأنفسهم عن السياسة الحزبية القائمة على التنافس والسعي حول السلطة. مقابلة عن بعد مع السيد ياسين بكر، عضو مكتب الاتصال بالجامعة البهائية المغربية.
[5] كل هذا لا ينفي -بطبيعة الحال- أن بعض البهائيين المغاربة لا زالوا يجدون بعض الصعوبات ويواجهون بعض الإكراهات، فبالرغم التطبيع شبه الرسمي الحاصل في التعامل معهم، سواء تعلق الأمر بالسلطات الأمنية أو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ببعض المنابر الإعلامية، إلا أنهم مازالوا يفتقرون إلى إطار تنظيمي يمثلهم تمثيلا قانونيا، على الرغم من أنهم يَنتخبون سنويا محافل روحانية تدير شؤونهم الدينية والاجتماعية على المستويين المحلي والمركزي. تصريح محمد منصوري: ممثل البهائيين المغاربة حول التعايش الديني بالمغرب متوفر بالمكتبة الرقمية للجامعة البهائية المغربية، تاريخ الاطلاع أكتوبر 2022.
[6] تصريح للسيد محمد سعيد: مسيحي مغربي وباحث في مركز مدى للدراسات في مقابلة بتاريخ 02 ماي 2023.
[7] تحدي التنصير، المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، تقرير الحالة الدينية في المغرب 2018-2019، الفصل السادس،، ص232.
[8] الشيء الذي يعتبر إشارة دالة على تحول الموقف الرسمي إزاء ملفهم كمسيحين مغاربة باعتباره ملفا حقوقيا وليس ملفا دينيا. محمد ضريف: الحقل الديني المغربي، ثلاثية السياسة والتدين والأمن، م.س.ذ، ص284.
[9] نفس المرجع، ص 233.
[10] ''كتنسيقية المسيحيين المغاربة''، فضلا عن ''الكنيسة المغربية الجامعة''، إضافة إلى ''اتحاد المسيحيين المغاربة''.تقرير الحالة الدينية لوزارة الخارجية الأمريكية، م.س.ذ، ص2.
[11] محمد السروتي: تساؤل عن الجهود الرسمية لمواجهة ظاهرة التنصير - المغرب أنموذجا، الألوكة، م.س.ذ.
[12] المخابرات ترصد 45 ألف مغربيٍّ اعتنقوا المسيحية، جريدة النهار المغربية، عدد: 184 تاريخ 31 دجنبر 2004.
[13] تقرير الحالة الدينية لوزارة الخارجية. لسنة 2021، ص 2.
[14] نسبة إلى ميزرا غلام أحمد القادياني الذي عاش في الفترة من 1835-1908 والذي قال عن نفسه "إنه المسيح الموعود والمهدي المنتظر"، الذي بُشر بأنه يأتي في آخر الزمان، وقد استمر في دعوته حتى وفاته في العام 1908 ليخلفه خمسة من (خلفاء الأحمدية) حتى الآن. تولى خلافة الأحمدية مؤخرا خليفتهم الخامس ميرزا مسرور أحمد والمقيم في لندن حاليا. للمزيد حول القاديانية يُنظر عمر النجار: القاديانية، مجد المؤسسة للدراسات والنشر و للتوزيع، بيروت، 2005، ص 8 .
[15] رضوان مبشور: في موقع الجماعة الأحمدية بالمغرب، مقال منشور في جريدة الأيام 24 في19 دجنبر 2017، تاريخ الاطلاع يناير 2022.
[16] بلغ عدد الأحمديين 750 وفق آخر تقرير سنوي للحالة الدينية بالمغرب، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، م.س.ذ.
[17] ياسين أروين: القاديانية تغزو المغرب ووزارة الأوقاف تدق ناقوس الخطر، مقال منشور في شبكة أندلس الإخبارية بتاريخ 18 نونبر 2013 .
[18] عبد الرحيم الشرقاوي: مقابلة مع زعيم الجماعة الإسلامية الأحمدية، منشورة على موقع أصوات مغربية، عبر الرابط المختصر: https://bit.ly/3zHFj31
[19]وهو نفسه ما صرح به الملك محمد السادس في مراسيم خطابه أثناء استقبال البابا فرانسيس مارس 2019، حيث قال: “بصفتي ملك المغرب، وأمير المؤمنين، فإنني مؤتمن على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأنا بذلك أمير جميع المؤمنين، على اختلاف دياناتهم”، للإطلاع على مضمون الخطاب الملكي صوتا وصورة، يرجع إلى موقع رئاسة الحكومة المغربية.
[20] مقابلة عن بعد مع السيد إلياس أمج: مدير ملتقى الأحمديين المغاربة. بتاريخ 27 يوليوز 2023.
[21] أحمد مرزا غلام: فتح الإسلام، توضيح المرام، إزالة الأوهام، ترجمة عبد المجيد عامر، ج3، ط 2 2015، ص 601-603.
[22] إدريس هاني: المغرب والتشييع- أية علاقة؟ مجلة وجهة نظر، العدد: 39 لسنة 2009، ص 18.
[23] عبد الحكيم أبو اللوز: تحولات الموقف المغربي الرسمي من التشييع (2014-1981)، مركز المسبار للدراسات والبحوث، يونيو 2016 ص 40.
[24] لا يمكن القول بأن عملية التشيع كانت مقتصرة على بعض الشيعة المشارقة فقط، بل انخرط فيها أيضا بعض المغاربة الذين تشيعوا وفي مقدمتهم ''عبد اللطيف السعداني'' الذي كان أول مغربي تخرج من حوزة القائم بالعاصمة الإيرانية سنة 1964 وعاد لتدريس الأدب الفارسي في الجامعة المغربية، ولم يكتف عبد اللطيف السعداني بالتعريف بالعقيدة الشيعية من خلال دراساته ذات الصلة بالموضوع، بل ساهم في دفع مجموعة من الأساتذة الجامعيين بفاس إلى التحول إلى العقيدة الشيعية مطلع التسعينيات من القرن الماضي. محمد ضريف: الحقل لديني المغربي، م.س.ذ.ص265.
[25] الحسين، الزاوي، المغرب العربي وإيران.. تحديات التاريخ وتقلبات الجغرافيا السياسية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، يناير (كانون الثاني) 2011، ص9.
[26] عبد العلي، حامي الدين، العلاقات الإيرانية من القطيعة إلى الانفتاح، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 17يناير 2011.
[27] استمرت القطيعة زهاء عقدين من الزمن تحديدا إلى حدود تاريخ وفاة الخميني. الذي شكل منعطفاً في مسار العلاقات الثنائية، حيث دخلت في مرحلة جديدة من الانفتاح بفعل تغيير موقف النظام السياسي الإيراني من ثوابت المملكة وعلى رأسها قضية مغربية الصحراء. قبل أن يتم قطعها نهائيا مرة أخرى في مارس من عام 2009، بعدما تم التأكد من قيام إيران بأنشطة تستهدف الإساءة بمقوماته الدينية ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي. محمد، الحيدري، «التحولات الجيوبوليتيكية»، الجغرافيا الجديدة للأمن الإيراني، مجلة شؤون الأوسط، العدد (121)، 2006، ص49.
[28] أشار تقرير الحالة الدينية الصادر عن مكتب الدراسات الدينية التابع لوزارة الخارجية غلا أنعدد المتشيعين في المغرب بلغ سقف 10000 متشيع، يتنوعون بين متشيعين مغاربة يشكلون أغلبية، مقابل شيعة أجانب يقدرون بنحو 1000 إلى 2000 مقيم أجنبي شيعي من لبنان وسوريا وتونس والعراق. تقرير الحالة الدينية الصادر عن وزارة الخارجية برسم سنة 2021، ص 2.
[29] نسبة إلى المرجع الشيعي محمد الشيرازي العراقي، أحد مراجع الدين الشيعة المعروفين بكونهم لا يتقون على عقائدهم والتصريح بها، كتكفير الصحابة واتهام أمهات المؤمنين…، له ألقاب عديدة منها الإمام الشيرازي والمجدد الشيرازي الثاني، وسلطان المؤلفين. نظرة عامة على الإمام الشيرازي، عبر البوابة الرسمية للتيار الشيرازي www.alshirazi.com
[30] محمد ضريف: الحقل الديني المغربي....، م.س.ذ، ص271.
[31] نسبة إلى علي حسيني خامنه المعروف بـ علي خامنئي المتشدد والذي يشغل منصب الولي الفقيه، والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية منذ 4 يونيو 1989 بعد وفاة روح الله الخميني. للمزيد حول حياته يراجع موقع سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي على البوابة الرسمية https://www.leader.ir/ar
[32] محمد قنفودي: : إرهاصات تسييس الشيعة المغاربة: حذر الدولة ورغبة الانفتاح السياسي، المعهد المغربي لتحليل السياسات، 2018، ص 9.
[33] هو علي بن محمد باقر بن علي الحسيني السيستاني، الملقب آية الله العظمى، من مواليد 4 أغسطس 1930 عالم مسلم وفقيه جعفري إيراني، ومرجع ديني للشيعة الاثنا عشرية الأصولية منذ عام 1992م، وهو من أكثر الشخصيات تأثيرًا في العراق نظراً لامتداد مرجعيته الدينية، البوابة الرسمية للسيستانيين https://www.sistani.org/arabic/data/1/
[34]على المستوى القيادي، تم التنصيص على تعييّن ''حضرة عبد البهاء'' الابن الأكبر للمؤسس ''بهاء الله'' باعتباره المبين الوحيد لكلماته، وذلك من خلال منحه سلطة التشريع في الأمور غير المنصوصة لبيت العدل الأعظم، الذي بدوره عيّن في ألواح وصاياه؛ حفيده حضرة ''شوقي أفندي'' وليا لأمر الدين البهائي أما على المستوى المؤسسي، فيعتبر بيت العدل الأعظم الهيئة الرئيسية العليا في النظم الإداري البهائي، وتحت هدايته تتولى الهيئات المنتخبة التي تُعرف بالمحافل الروحانية المركزية، والمحلية، رعاية أمور الجامعات البهائية، حيث تباشر سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، بمساعدة مؤسسات تتشكل ممن يتم تعيينهم للعمل على تعزيز التعلّم في الجامعة البهائية. علاء عبد الرزاق مطلك: الديانة البهائية في العالم: تاريخها، تعاليمهاـ وعلاقتها بإسرائيل،
[35] المحافل الروحانية البهائية هي المؤسسات التي تدير الشؤون الدينية والاجتماعية والتربوية للبهائيين على المستوين المحلّي والمركزي تنتخب كل سنة خلال أعياد الرضوان التي تصادف الثلث الأخير من شهر أبريل في التقويم الميلادي. من نحن نبذة تاريخية، موقع الجامعة البهائية المغربية.
[36] تصريح محمد منصوري: ممثل البهائيين المغاربة حول التعايش الديني بالمغرب متوفر بالمكتبة الرقمية للجامعة البهائية المغربية، تاريخ الاطلاع أكتوبر 2022.
[37] مقابلة مع السيد ياسين بكر، عضو مكتب الاتصال للبهائيين المغاربة. م.س.ذ.
[38]تختلف التسميات التي تطلق على هذه المرافق ما بين الكنائس المنزلية و الكنائس السرية، أو الكنائس المحلية، أو الوطنية الصاعدة، أو الكنيسة البسيطة أو الكنيسة العضوية لكن الخاصية المشتركة بين كل هذه التوصيفات أن الكنيسة السرية هي تلك التي لا تتبع لكنيسة رسمية معترف بها من طرف السلطات، إنها فضاء تعبدي وتعليمي للمتنصرين. جريدة المساء، عدد 15 ماي 2015.
[39]محمد اليوبي: المسيحيون المغاربة.. من هم؟ وكيف يعيشون؟ ، جريدة المساء، عدد 23 دجنبر 2015.
[40] بالإضافة إلى هذه المؤسسات الرئيسية تتوفر الجماعة الإسلامية على مجموعة أخرى من المؤسسات المساعدة مسؤولة عن التدريب الروحي والأخلاقي لأعضائها، كمنظمة "لجنة إماء الله" هي الأكبر من بين جميع المنظمات وتتألف من عضوات فوق سن 15 سنة. فضلا عن ''مجلس خدام الأحمدية'' للأعضاء الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 40 سنة؛ ومجلس ''أنصار الله" للأعضاء الذكور فوق سن الأربعين؛ و'"نصيرات الأحمدية"' للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 7 و 15 سنة؛ و''أطفال الأحمدية'' للصبيان الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 15 سنة. ملامح الجماعة الإسلامية الأحمدية، مقال منشور في البوابة الرسمية للجماعة الإسلامية الأحمدية عبر الرابط التالي https://www.islamahmadiyya.net/inner.asp?recordID=1664
[41] زادت قيمة مقر الخليفة منذ النفي القسري للخليفة الرابع من باكستان في عام 1984، كان المقر الفعلي للجماعة موجودًا في مسجد فضل في لندن، إنجلترا. في عام 2019، نقل الخليفة الخامس المقر الرئيسي إلى إسلام آباد، في تيلفورد، إنجلترا على أرض اشترتها الجماعة في عام 1985.
[42] عبد الرحيم الشرقاوي: مقابلة مع زعيم الجماعة الإسلامية الأحمدية، منشورة على موقع أصوات مغربية، عبر الرابط المختصر: https://bit.ly/3zHFj31
[43] منتدي أحمدي نشيط على منصة التواصل الاجتماعي، يديره السيد إلياس أمج. يضم ما يزيد عن 1000 عضو، يناقشون أبرز الإشكالات التي تعترض تدينهم، بكيفية دورية ومستمرة.
[44] رضوان مبشور: حوار مع عصام الخامسي زعيم الحركة الإسلامية الأحمدية بالمغرب، مجلة الأيام 24 بتاريخ 11 دجنبر 2017.
[45] سكينة بنزين: مغاربة يعتنقون الأحمدية، جريدة الأحداث المغربية في 30 دجنبر 2016.
[46] راجع الفقرة الثانية من المطلب الثاني من المبحث الثاني للقسم الأول.
[47] محمد قنفودي: إرهاصات تسييس الشيعة المغاربة... م.س.ذ، ص 8.
[48] يقصد بالتقية عملية إخفاء المعتقد الديني وعدم إعلانه للعموم خوفا من القمع، وهي تقنية لتدبير الخلاف العقدي مع المحيط الاجتماعي يقوم من خلالها الفاعل الشيعي بالتستر كليا أو جزئيا على توجهاته العقدية بهدف تفادي الصدام المباشر مع المجتمع والدولة. نفس المرجع، ص10 -11.
[49] طبقا لعلماء أهل السنة فإن المكان الشرعي الوحيد للعبادة في الإسلام هو المساجد، حيث إن شعائر الإسلام تؤخذ من مصادر القرآن والسنة النبوية وحيث إن الحسينيات هي مظهر مستحدث لم يشر إليها المصدران فلا يجوز بناؤها، كما ان الشعائر التي تقام بها ليست مشروعة بل هي بدع لم ترد في القرآن ولا في السنة، فعلى الرغم من تبجيل أهل السنة للحسين وآل بيت النبي لكنهم يرون أن الشيعة يبالغون في هذه المحبة إلى الحد الذي يجعلها تخالف تعاليم الإسلام الصحيحة.
[50]وهو التاريخ الفاصل من بين العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، تاريخ استشهاد الإمام الحسين (ثالث الأئمة عند الشيعة) و20 صفر تاريخ الذي يجسد أربعينية الحزن التي يخلدها الشيعة في كل عام.
[51] في حوار مع الباحث محمد أكديد بتاريخ 30 ماي 2023، نفى هذا الأخير بصفة قطعية وجود الحسينيات بالمغرب، واعتبر أن هذه التجمعات إن وجدت فإنها تكون في بيوت بعض الإخوة دون أن تصل إلى رتبة الحسينات كما هي متعارف عليها في دول المشرق.
[52] صرح السيد كمال الغزالي، رئيس تحرير "المواطن الرسالي" في تعليق له على تقرير أمريكي حول حريات الشيعة بالمغرب، حيث قال في معرض حديثه عن مدى الحاجة إلى مساجد خاصة بالشيعة "الحسينيات في هذه المرحلة ليست جزء من تفكيرنا، فاهتمامنا منصب بالأساس حول المسجد فقط". حسن أشرف الغزالي: الترخيص لمساجد خاصة بالشيعة "ممكن" حوار بتاريخ 2 نونبر 2015 منشور في موقع الخط الرسالي.
[53] عبد الحفيظ بلقاضي: المتحدث الرسمي باسم التيار الرسالي بالمغرب، في حوار بتاريخ 04 شتنبر 2020.
[54] قد تصل المسألة في حالة استمرار تصلب المواقف من الشرعية الدينية للنظام إلى إرساء إقصاء سياسي ممنهج، إما بالاستعانة بالضغوطات القضائية عبر فتح ملفات قضائية خاصة برموز هذه التيارات الدينية لدى المحاكم بهدف الزج بهم في معارك قانونية وقضائية لتشتيت جهودهم التعبوية وتشغلها، وتساهم في عرقلة نشاطاتهم إلى حين صدور حكم يقضي إما بالإدانة أو البراءة، أو عبر الضغوطات القانونية: برفض الاعتراف القانوني بوجود هذه التيارات، واعتماد سياسة المراوغة والصرامة الإدارية، عبر وضع إجراءات مسطرية تعجيزية، لممارسة التضييق والبيروقراطية، وعدم الاكتراث بالملفات المقدمة وتوليد الإحساس بذلك وربما إهمال بعض وثائقها أو في تسليم وصل التأسيس النهائي أو الامتناع عن تسليمه بمبررات عدم اكتمال الملف أو عدم استيفائه للشروط القانونية أو بوجود بعض الثغرات القانونية أو عدم احترام الإجراءات المسطرية المعتمدة أو المستجدة، أوعبر ضرب قوة التيارات المادية والاجتماعية، وذلك باعتقال القيادات والرموز والتحقيق معهم أو محاكمتهم وغلق مقراتهم. مما قد يؤدي إلى خلق نوع من الارتباك داخل هذه التيارات في محاولة لعزل القيادات عن قواعدها أو خلق حالة من الفراغ القيادي، ناهيك عن الضغوطات الإعلامية عبر عدم دعوة هذه التيارات والقوى التي تمثلها للأنشطة الإعلامية التي تنظمها السلطة، ومنعها من الحضور في الإذاعة والتلفزيون للتعبير عن مواقفها وإظهارها بمثابة الفئة المعزولة والمحدودة التأثير. رشيد مقتدر: الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى 2010، الصفحات 143-144.
[55] بلاغ وزارة التعاون والشؤون الخارجية، الرباط، في 6 مارس 2009.
[56] كان الراحل الحسن الثاني يشترط على جميع التيارات الدينية الإسلامية منها وغير الإسلامية ضرورة احترام ثلاثة شروط أساسية: أولها رفض التأثيرات الخارجية وخاصة المد الشيعي، ثانيها رفض أي عمل تنسيقي للتنظيمات الإسلامية المغربية مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أو حزب التحرير الإسلامي أو غيره أو الانخراط فيه، ثالثا: اشتراطه نبذ العنف والعمل المسلح أساسا للإدماج في الحياة الاجتماعية والسياسية. رشيد مقتدر: الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب، م.س.ذ، ص 140.
[57] محمد ضريف: الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن..، م.س.ذ، ص 284.
[58] رضوان مبشور: حوار مع عصام الخامسي زعيم الحركة الإسلامية الأحمدية بالمغرب، مجلة الأيام 24، مقال منشور بتاريخ 11 دجنبر 2017، تاريخ الإطلاع 15 يناير 2023.
[59] رضوان مبشور: حوار مع عصام الخامسي زعيم الحركة الإسلامية الأحمدية بالمغرب، م.س.ذ.
[60] الوضعية الراهنة للبهائيين المغاربة، من موقع الجامعة البهائية المغربية.
[61] مقابلة مع السيد ياسين بكر، عضو مكتب الاتصال بالجامعة البهائية المغربية، بتاريخ 26 أكتوبر 2022.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 













 التدين الخفي بالمغرب؛ أنماطه، ومستويات تدبيره
التدين الخفي بالمغرب؛ أنماطه، ومستويات تدبيره