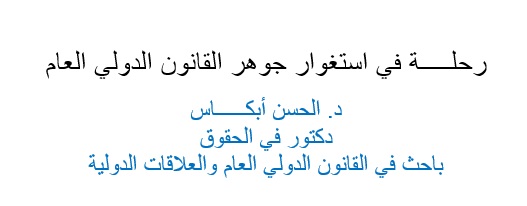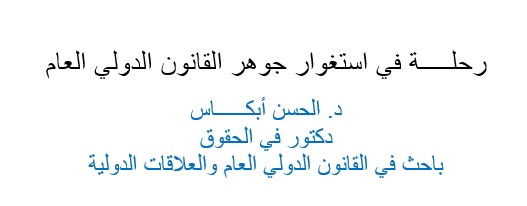
عندما وصلت إلى كلية الحقوق لأول مرة، دخلت إلى المكتبة. اعتقدت أنها كانت مجرد غرفة مرجعية صغيرة، ولكن عندما بدت لي صفوف رفوف الكتب، لم أستطع كبح التنهيدة التي رافقت النظرة إلى زخم وثراء المجموعة القانونية. بعد التنهد، دخلت هذه الخلوة، وجلست ببطئ، وشعرت أن إحساساً بالاندماج في هذا العالم قد انتابني بيسر وسرعة. في هذه اللحظة، خطرت فجأة إلى ذهني فكرة تتساءل: هل يمكن لكل طلاب القانون في جامعتي، والذين جلسوا هنا، والتهموا، بنهم، كل هذه الكتب أن يكونوا محامين، وقضاة، وديبلوماسيين، ورجال قانون جيدين؟ الطلاب الذين تخرجوا من هنا، وصاروا أشخاصًا اعتباريين محترفين في المستقبل، هل سيعودون إلى احتضان أحلامهم السابقة، ويستعيدوا هذه الفترة الدافئة من الدراسة؟
لقد أمضيت بعض الوقت في قراءة بعض الكتب عن القانون الدولي وعن السياسة الدولية، ولم أستوعب، قدر الإمكان، من جوهر هذا القانون، إلا ما يرافقني من التأثر ببعض رموزه من مختلف المشارب والمدارس القانونية الفرنسية بالخصوص. ولم تكتمل لدي الصورة إلا بعد أن استمعتُ، وقرأتُ، وتابعتُ، وناقشتُ في أدبيات القانون الدولي. لأدرك حينها أن أقل ما يمكن وسم القانون الدولي العام به هو أنه "قانون".
بعدها انطلقت خطوات رحلة الألف ميل، بالبحث النظري والممارسة العملية، من خلال دراسات في قضايا السيادة في القانون الدولي واتجاهات تنميتها، وتاريخ القانون الدولي العام، وأدبيات الاقتصاد الدولي الجديد، وتاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، وتحليل النظام الدولي، والعالم الديبلوماسي...إلخ. مع محاولة استكشاف بعض النظريات الأساسية للنظام والقانون الدوليين في علاقة مع خلفية التاريخ العميق والواقع الدقيق. والتركيز على العديد من التطورات الجديدة في تحليل السيادة الوطنية في القانون الدولي، ومناقشة التطور التاريخي للقانون الدولي، وتحليل سلسلة من قضايا المنظمات الدولية والقانون الدولي، ودراسة قوانين وسياسات الطاقة الدولية ومرجعيتها. وكل ذلك في إطار رؤية واسعة، وتركيز بارز، ومعلومات غنية، ودليل صارم.
كانت الإنطلاقة مع استغوار العلاقة بين القانون الدولي والسياسة الدولية. وهو عموماً، سؤال مألوف: ما هو القانون الدولي؟ فمن الناحية المفاهيمية، القانون الدولي العام هو "مجموعة القواعد الملزمة قانونًا للدول في تعاملاتها وتفاعلاتها البينية"، بينما تشير السياسة الدولية إلى "المنظومة التي تشكلت من خلال أنشطة، وتفاعلات الجهات الفاعلة، التي تنفذ صنع القرار الخارجي حول الحقوق، والسلطات، والمصالح". والمفهومان (القانون الدولي العام والسياسة الدولية) يتجسدان في ظواهر وعلاقات الحرب والسلام، والصراع، والتعاون، والسلطة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والسيادة، والاستغلال، والتنمية، والتحالف، وعدم الانحياز، والاضطراب، والنظام، وذلك على نطاق عالمي شامل".
وهنا لا يسعني، في مرحلة لاحقة، إلا طرح سؤال على الفقه حيَّرني: ما هو هدف القانون عموماً؟ حيث وجدت ضالتي، حين بدَا هذا واضحاً من منظور فرع القانون؛ بكل بساطة، الغرض من الدستور هو تنظيم السلطة وحماية الحقوق. والغرض من القانون الجنائي هو تحديد الجرائم ومعاقبة المجرمين، مع العمل على جعل الجاني يعود إلى مجتمعه كشخص اجتماعي عادي. والغرض من قانون العقود هو الحفاظ على نظام وأمن واستقرار المعاملات. والغرض من القانون الدولي هو الحفاظ على النظام الدولي، وتعزيز التعاون المشترك، والسهر على تطور المجتمع البشري.
وبهذا المعنى، يجب أن يكون القانون الدولي أكبر من السياسة الدولية؛ فبعد كل شيء، تخضع العلاقات بين دول العالم اليوم لقوانين وأنظمة مختلفة، تشكلت على مدى سنوات عديدة. ومع ذلك، ومن وجهة نظر عملية، فالدولة تتعامل مع القضايا السياسية الدولية وفق فلسفة تقوم، بشكل أساسي، على المصالح الوطنية وعلى متطلباتها الأمنية، بدلاً من الحكم أولاً بالصواب والخطأ من وجهة نظر القانون. صحيح أن القانون الدولي العام يبرز جلياً على مستوى العلاقات بين الدول، لكن لا يمكن أنفاذه إلا بتضافر جهود كل الجماعة الدولية، وأي محاولات أخرى من جانب الفقه أو التشريع الدوليين، أكيد غير مضمونة التحقق ما دام الأمر معلق على تبعات التفاعلات الدولية.
إن تأثير السياسة الدولية على القانون الدولي العام ليس بعيد المدى، لأنه بدون تلك السياسة، لا يمكن أن يكون هناك قانون دولي، لأن قواعده -أي القانون الدولي العام- يتم تشكيلها وخلقها في عملية التغييرات التي تطرأ على السياسة الدولية. وبعد إنشاء قواعد القانون الدولي، لا يمكن أن يكون لها وجود منعزل. وتتأثر، بشدة، بجميع متغيرات المجتمع الدولي، وخاصة متغيرات السياسة الدولية. لذلك، هناك اتجاه للعدمية في القانون الدولي يرى أن القانون الدولي ليس نظاماً أو قانونًا ناعمًا. لكن، كيف ذلك؟ مع تسارع العولمة، واحتواء اتجاه التعددية القطبية في العالم، وتأثير الرأي العام الدولي، كان لزاماً على الدول أن تعتمد، بشكل أكبر، على القانون الدولي لضبط النظام الدولي المعقَّد، لأن القانون الدولي يمكن أن ينشئ ضمانًا للسلام الدائم.
إن النظام الدولي الجديد، الذي يعمل بشكل وثيق مع الدول، يقلل من فوضى المجتمع الدولي، ويمنع، نسبياً، قوانين القوة من الانتشار على مستوى العالم. العالم يدعو إلى السلام، والتنمية، والديمقراطية، والازدهار المشترك، وعديدة هي القضايا العالمية التي تتطلب تدخل القانون الدولي لتقويمها؛ ولعل أكثرها وضوحاً، حماية البيئة العالمية، والسيطرة على التسلح، والتجارة الدولية. وإن كانت العوامل "الصعبة" للقانون الدولي تتزايد تدريجياً؛ إذ لا تزال المعايير المسيطرة تستند على "قانون الإرادة"، ولكن هذا لا يمنع أن هناك، بالفعل، عدد من المعايير الإلزامية، بل وتتنامى قوة الإلزام فيها باستمرار. حيث يمكن توقع أنه، على الرغم من أن السياسة الدولية تقيد تطور القانون الدولي العام، من وقت لآخر، من منظور تطور هذا القانون، إلا أن الحد من تأثير السياسة الدولية، أوضبطها، أو الحد منها تدريجياً، هو اتجاه حتمي لتطورها.
إن السبب الأساسي الذي يجعل البعض يعتبر القانون الدولي العام "قانون غير ملزم"، هو أن معايير هذا القانون متطبِّعة بمرونة كبيرة على مستوى تقييد سيادة الدولة. وهذا واضح، بشكل خاص، في العلاقة بين حقوق الإنسان والسيادة.
ولاستكشاف كيف تقيد قواعد القانون الدولي العام السيادة لغاية حماية حقوق الإنسان، يجب علينا، أولاً، توضيح ما إذا كانت حقوق الإنسان أعلى من السيادة أم أن السيادة أعلى من حقوق الإنسان. وقد نوقش ذلك في الأوساط الأكاديمية لسنوات عديدة. ومن الواضح أن النظرية عالية الأيديولوجية (السيادة أعلى من حقوق الإنسان) تجعل من السيادة مطلقةً ومقدسةً، وتتدحرج بحقوق الإنسان إلى خانة العبودية بل وإلى التغاضي عنها. وكمبدأ أساسي في القانون الدولي العام، يستوجب عنصر حقوق الإنسان حمايةً دوليةً لتلك الحقوق، ويضع موضع التساؤل موضوع السيادة الدولية.
لمزيد من التوضيح، فموضوع الحماية الدولية لحقوق الإنسان وموضوع السيادة الوطنية ليسا متناقضين تمامًا، يكفي فقط النظر إلى العلاقة بينهما بشكل جدلي؛ من ناحية، مبدأ السيادة هو حجر الزاوية لوجود المجتمع الدولي اليوم، والخندق الأول لإعمال حماية حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، فإن تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان هو المهمة المشتركة، والهدف الأسمى للدول ذات السيادة. ومن الضروري، أيضاً، احترام السيادة الوطنية، ومنع الاستغلال السياسي للحماية الدولية لحقوق الإنسان، كما جاء في الوثيقة الختامية المعتمدة في قمة حركة عدم الانحياز العاشرة، عندما نصت على أنه: "لا يجوز استخدام حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي، خاصة بين أوساط بلدان عدم الانحياز والبلدان النامية الأخرى". ويحق لجميع البلدان أن تتبنى، بحرية، نظمها ومؤسساتها السياسية والاقتصادية الخاصة بها، على أساس احترام السيادة الوطنية، وتقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى". فكيف، إذن، نقارب العلاقة بين الحماية الدولية لحقوق الإنسان، والسيادة الوطنية، والتدخل الإنساني؟
في الظاهر، يبدو أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان والتدخل الإنساني لهما تأثير على قضايا حقوق الإنسان في بلد أو منطقة معينة، من أجل تحقيق الغرض من الحماية. ذلك أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تقوم على روح ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعلى أساس احترام السيادة الوطنية. وغالبًا ما يتم تقليل التدخل الإنساني في مواجهة الدول الغربية التي ترفع دائماص شعار الحماية تلك لفرض معايير وقيم حقوق الإنسان من وجهة نظرهم. وهذا تشويه للحماية، ويؤدي إلى تفاقم الأجواء والعلاقات الدولية، ويعزز الهيمنة، وإلى انعدام عوامل الأمن والاستقرار في العالم. لكن من المؤكد أنه في القانون الدولي العام المعاصر، تعد التدخلات الإنسانية الجماعية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، الوسيلة القانونية الوحيدة القادرة على استخدام القوة لحماية حقوق الإنسان الأساسية، وأي تدخل من دولة، أو مجموعة من الدول، لدواعٍ إنسانية، خارج هذا الإطار يعتبر غير قانوني.
وهنا أتذكر مقولة الباحث البريطاني جاكارد لاسكي LASKEY J. عندما قال بإن الدول الغربية التي تتبنى أطروحة "سمو حقوق الإنسان على السيادة" لها اعتباراتها التاريخية والاجتماعية. ويمكن القول، إن مفهوم السيادة يتعرض للهجوم، والنقد، واللوم، والتشويه، منذ أول ما طرحه رسمياً الفقيه جون بودان BODIN J.. بينما السيادة غير ضارة وغير مفيدة في آن، بل يجب العمل على إيجاد "عالم بلا سيادة"، حتى إن شارل جينكس JENECKS C. (1939-2019م) كان إعتقد أن السيادة مؤسسة على خصائص ثلاث، هي: "الفوضى المؤلهة، والوحش الشرعي، والشر الأخلاقي". كما كان كتب لويس هنكين HENKIN L. (1919-2010م) قائلاً: "تطورت السيادة إلى أسطورة العظمة، والقوة الوطنية؛ هذه الأسطورة تشوه مفهوم السيادة، وتُخفي معانيها وقيمتها الحقيقية. هذه الأسطورة غالبًا ما تكون فارغة، وأحيانًا تدمر القيم الإنسانية...لكن الأكثر شيوعًا، تم التذرع بالسيادة كتدبير لمواجهة "الاجتياحات" المختلفة القادمة من الخارج، وتستخدم هذه التدابير لرصد (الرعايا) ومراقبة مدى الالتزام الدولي في مجال حقوق الإنسان، والالتزامات الدولية، وعلى مستوى التسلح...الآن حان الوقت لإعادة السيادة إلى الأرض، وإعادة النظر فيها، وتحليلها، وإعادة التفكير فيها، وإعادة تعبئتها، وحتى إعادة تسميتها ".
صحيح أن السيادة أداة لحماية وتحقيق المصالح الوطنية؛ ففي التاريخ، ارتُكبت جرائم بشعة ضد الشعوب باسم السيادة، مما ألهم الأجيال القادمة لإعادة النظر في مفهوم "السيادة المطلقة". ومع ذلك، وبغض النظر عن كيفية تفكيرنا، فإن السيادة الوطنية هي وجود موضوعي لا يمكن إنكاره؛ فهو لا يتصوره ولا يخلقه الناس بأي حال من الأحوال. وإن كان بعض العدميين لا يدخرون أي جهد في مهاجمة السيادة، لكنهم في الغالب يهاجمونها في إطارها المطلق فقط، ولا ينكرون وجودها. ليس هذا فقط من الناحية النظرية، بل ومن الناحية العملية أيضاً، حيث تم تأكيد مبدأ السيادة من خلال العديد من الوثائق القانونية الدولية، وعبر النظام القانوني الدولي بأكمله، بل إن هذا المبدأ هو أساس القانون الدولي الحديث وجوهره. والسيادة ليست أسطورة تحفز الشعوب وحكوماتها على التصرف في الشؤون الدولية بقوتها الهائلة. بل هي ضرورة عملية لا يمكن فصلها أو اجتزاؤها من القانون الدولي العام. وبالفعل، موضوع "نظرية السيادة" هو موضوع معقَّد للغاية.
جانب آخر من الجوانب التي تستفز ملَكة الباحث في أدبيات القانون الدولي والسياسة الدولية، ما يرتبط بآليات وميكانزمات إنفاذ وتطبيق القانون الدولي العام، خاصة على مستوى منظمة الأمم المتحدة، مع خصوصية هذه الآلية، ونداءات التعجيل بإصلاحها. فكيف يمكن تحليل الأساس النظري والقانوني لعمل وإصلاح الأمم المتحدة؟
من وجهة نظر شخصية، وقد تحتمل الخطأ، إصلاح منظمة الأمم المتحدة هو التكيف مع التغيرات التي تطرأ على العلاقات الدولية قصد تحسين الكفاءة والمردودية. ورصدنا لجل التيارات في هذا الباب هو الذي يجعلنا اليوم نقول بأن التطور النظري للأمم المتحدة له أساسان نظريان: مواجهة تحديات جديدة، وأزمة النظام القانوني الدولي.
الكل سيلاحظ أن المواجهة اختفت، بعد انتهاء الحرب الباردة، بين قطبي الرحى (موسكو وواشنطن) ومن يحوم حول حماهما، لكن النزاعات العرقية، والطائفية، والدينية التي طغت على النظام القديم لم تكُف مرارًا وتكرارًا عن الطفو على السطح، واستمر الانقسام الإقليمي في التنامي، وقد أصبحت الفوضى في العلاقات الدولية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، خاصة عقب أحداث نيويورك (11 سبتمبر 2001)؛ فبعد الهجوم، كان هناك سبب أكثر للقلق بشأن الانقسام العالمي الأكثر حدة. وفي الوقت نفسه، يتصاعد مد العولمة، ولفتت انتباه الناس قضايا الأمن غير التقليدية العابرة للقارات. مثلما قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة (كوفي أنان): "إن عالم اليوم مختلف تمامًا عن عام 1945م".
منذ إقدام واحد وخمسون دولة على تأسيس الأمم المتحدة وحتى يومنا هذا، ازداد عدد الأعضاء بشكل كبير، وشهدت عملية مقاربة القوة السياسية الدولية أيضًا تغيرات كبيرة. حيث تقوَّت حتى قوى المحور في الحرب العالمية الثانية (ألمانيا واليابان)، وأصبحت تؤدي دوراً متنامياً في تدبير الشؤون الإقليمية والعالمية. وهي تدعم بنشاط إصلاح الأمم المتحدة وتأمل على وجه السرعة في أن تصبح أعضاء دائمين في مجلس الأمن. خاصة وأن النظام القانوني الدولي يواجه اليوم أزمة خطيرة، تجسدها ما تواجهه بعض المبادئ والنظم الأساسية للقانون الدولي العام من تحديات شديدة. غدَت عوامل محفزة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة.
ووقفة منا، في خضم هذا الجدل السياسي الدولي حول نجاعة المنظمة، جعلتنا نركز، ومن منظور قانوني صرف، على ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره الدستور الأساسي للمنظمة، حيث سجَّلنا أن تنفيذ الإصلاح يتم، بشكل رئيسي، بأسلوبين: أحدهما، يتوافق وإجراءات مراجعة الميثاق. والثاني تتبناه مقاربة "الإصلاح بأمر الواقع" في صوره الأربعة، وهي: التفسير الموسع لأحكام الميثاق، وإبرام "الاتفاقات المكملة الخاصة"، وإنشاء أجهزة فرعية، واعليق العمل بالعديد من أحكام الميثاق لفترة طويلة.
ولا يسعنا بعد هذه الإطلالة التحليلية النظرية لإصلاح الأمم المتحدة، إلا أن نشير إلى أن الإصلاح هو السبيل الوحيد لإعادة هيكلة الأمم المتحدة، لكن بشكل تدريجي، وذلك ضمانً للفاعلية والفعالية، وإن كان النجاح أو الفشل، في الأخير، يعتمد، وبشكل أساسي، على إرادة الدول الأعضاء أو مواقفها السياسية. وفي عصر التحول الكبير هذا، يجب أن تراعى السلاسة في إعادة "برمجة" الأمم المتحدة، بما لا يدع مجالا للفوضى المتجددة. ولا يمكن بغير هذه الطريقة بناء عالم جديد قائم على السلام، والاستقرار، والازدهار.
لا يمكن أن ننقب في قضايا القانون الدولي المعاصر دون أن نقف على التضارب الحاد في المصالح والتنافس الشديد على قضايا الطاقة، وإكراهات بلورة نماذج التعاون في المجال الطاقي، عبر آليات مختلفة كــ"معاهدة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، و "معاهدة ميثاق الطاقة الأوروبية"، و"ميثاق مجتمع الطاقة في شمال شرق آسيا"، وغيرها. ويمكن القول إن نوعاً جديداً من المنظمات الاقتصادية الحكومية الإقليمية والدولية، لا تزال تواجه العديد من المشاكل، خاصة مع التأثير السلبي على الأمن خلال فترة الحرب الباردة، الولايات المتحدة التي لديها قوات ثقيلة تتمركز في اليابان، وكوريا الجنوبية، ويتم تعزيز تحالفاتها العسكرية باستمرار. وإذا لم يتم حل القضية النووية لكوريا الشمالية، وقضية مضيق تايوان، ومختلف المظالم التاريخية، والنزاعات الإقليمية بشكل صحيح، فستفقد الصين واليابان وكوريا الجنوبية الوعي الإقليمي. مع العلم أن الولايات المتحدة لا ترغب في ظهور منافسين بديلين عن الاتحاد السوفيتي المنحل، كالصين (القوة التقليدية في آسيا) واليابان (باعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم يتمتع الاقتصاد بقوة قوية لا يمكن تجاهلها)، فاستراتيجية أي دولة كبرى للبحث عن مركز مهيمن، لا تؤدي إلى تعاون متعدد الأطراف.
لا يمكن الحديث عن القانون الدولي العام في كل مجالاته ونظرياته وتطبيقاته دون تعميق النظر في انتاج الفقيه هوغو غروتيوس GROTIUS H.، الذي أشادت به الأجيال القانونية، بصفته "أبو القانون الدولي"، و"أبو القانون الطبيعي". والذي اعتمد العقلانية اللاهوتية والإنسانية كأساس إيديولوجي له، من خلال كتابه "قانون الحرب والسلام. الذي طور فيه بعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي الحديث، مثل المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، والسيادة الوطنية، والتمييز بين الحروب العادلة والظالمة، ومبادئ التسوية السلمية للنزاعات، والقيود على أعمال الحرب، وحقوق وواجبات الدول المحايدة، والالتزامات بتنفيذ المعاهدات بحسن نية، وحرية البحار، وغيرها.
وإذا نظرنا إلى كتاب غروتيوس، من الزاوية الكلية، سنجده يسعى إلى البحث عن بيان وتوضيح "الضوابط الصحيحة والعقلانية" القائمة على الثقافتين القانونيتين اليونانية والرومانية القديمتين، وعلى القانون المسيحي، كأساس لتنظيم سلوك الدولة وعلاقاتها. وفي الوقت نفسه، تبنَّت نظرية القانون الوطني، بالمعنى الشامل، أيضاً، وجهة النظر الأساسية لمدرسة القانون الطبيعي الكلاسيكية.
فوفقا لغروتيوس، يمكن تقسيم القانون إلى قانون طبيعي وقانون إرادة؛ القانون الطبيعي هو ما يجود به العقل السليم من أوامر، والذي يشير إلى ما إذا كانت أفعال معينة تتوافق وطبيعة العقلانية، وما إذا كان لها أساس أخلاقي، أو ضرورة أخلاقية. وكان غروتيوس أول شخص يحرر فكرة القانون الطبيعي من لاهوت وثيولوجية القرون الوسطى، لأنه أوضح أن القانون الطبيعي غير قابل للتغيير. وبهذا المعنى، فهو خارج عن إرادة الإنسان تمامًا. ولا يكاد الواحد منا يتوغل في التطورات التي مر منها القانون الدولي العام حتى يقف على الحضور المكثف والتواصل لأفكار غروتيوس وتأثيرها الكبير على عملية التطور تلك.
بعد دراسة مسار القانون الدولي العام بشكل منهجي، وبعد قراءات في "تحليل القانون الدولي العام" وأدبيات السياسة الدولية في مقاطعها العميقة، لا أنكر أنه تكوَّن لدي رصيد أساسي بشأن الفهم الأولي للقانون الدولي. لكن ما جعلتني أشعر بالحزن قليلاً، تلك المشكلة التي علِقت في ذهني ولا تزال باقية: هناك ممارسة متطورة إلى حد ما في القانون الجنائي، وفي القانون الإداري...، وعلى مستوى السوابق القضائية في التاريخ العربي. نظام قانوني فريد من نوعه من منظور قيمي وديني بتقاليده الثقافية القانونية المميزة، ولكن لماذا لم تنتج الأنظمة القانونية العربية قانونها الدولي المعاصر في العصر الحديث مثل المجتمع الغربي؟
لمثل هذه المشكلة النظرية الرئيسية، لدي قدرة أكاديمية محدودة ولا أستطيع فهمها. في أفكاري، يبدو أن هناك شعور برؤية الفجر قبل الفجر. ولحسن الحظ قبل الفجر وليس بعده.. وإن فجر غد لناظره لقريب...



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 













 رحلة في استغوار جوهر القانون الدولي العام
رحلة في استغوار جوهر القانون الدولي العام